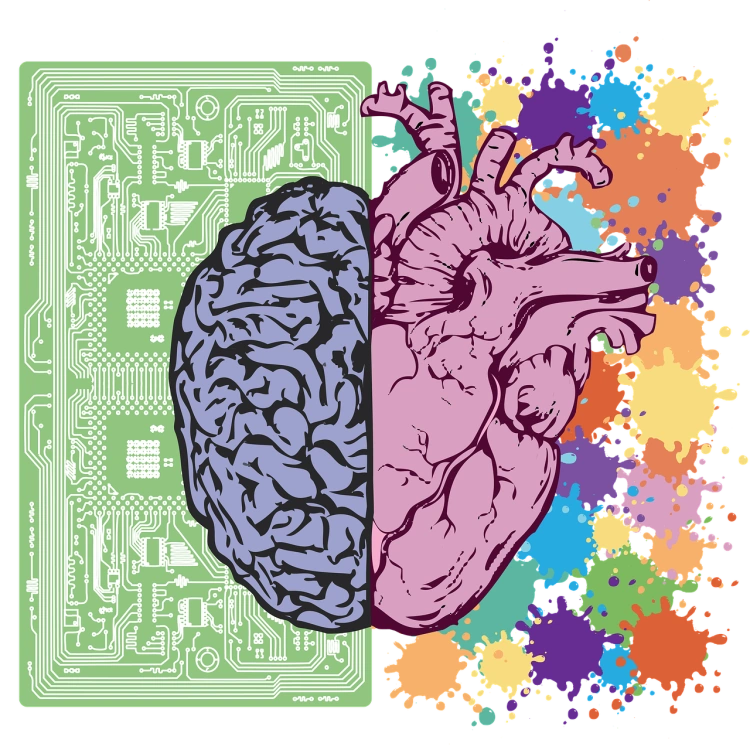مثل أصحاب القرية الذين كذبوا المرسلين
الأحد/ديسمبر/2019
﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالثٍ فَقالُوا إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قالُوا ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَكْذِبُونَ * قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَما عَلَيْنا إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ * قالُوا إِنّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ * قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُسْرِفُونَ * وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ * إِنّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ * إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ * قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمينَ * وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنّا مُنْزِلينَ * إِنْ كانَتْ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ * يا حَسْرَةً عَلى العِبادِ ما يَأْتيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾(يس: 13- 30)
أولاً- هذا مثل من الأمثال القصصية ضربه الله تعالى لعُبَّاد الأصنام، يحذرهم فيه من مغبة الكفر والشرك، وينذرهم أن يحل بهم ما حل بكفار أهل هذه القرية، بعد أن أصروا على كفرهم وشركهم بالله سبحانه. ويتضمن قياسًا من قياس التمثيل الذي يقوم على التسوية بين المتماثلين في الحكم. ومناسبته لما قبله أن الله تعالى بعد أن عرض في بداية السورة قضية الوحي والرسالة وقضية البعث والحساب في صورة تقريرية، عاد ليعرضهما في صورة قصصية، تلمس القلب بما كان من مواقف التكذيب والإيمان وعواقبهما معروضة كالعيان.
ولم يذكر القرآن شيئًا عن هذه القرية، ولا عن أهلها سوى أنهم كانوا أصحاب شرك يعبدون الأصنام، فأرسل الله تعالى إليهم رسولين – كما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملئه – فكذبوهما، فعزز الله تعالى برسول ثالث ؛ ليؤكد أنه، وأنهما، مرسلون من عند الله تعالى، لا من عند غيره. وتقدم الثلاثة بدعواهم ودعوتهم من جديد، وهنا اعترض عليهم أصحاب القرية بالاعتراضات المكرورة في تاريخ الرسل والرسالات، فكذبوا دعواهم، وردوا دعوتهم بحجج واهية تدل على سذاجة تصورهم وإدراكهم لحقيقة الرسل ؛ كما تدل على جهلهم بحقيقة الرسالة التي أرسلوا إليهم من أجلها. ولما أسقط في أيديهم، لجئوا إلى التهديد والوعيد، ولم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان يسكن في ناحية القرية، فلما سمع بدعوة هؤلاء المرسلين، استجاب لها بفطرته السليمة، بعد أن رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان، تحركت هذه الحقيقة في ضميره، فلم يطق عليها سكوتًا، وجاء من أقصى المدينة يسعى ؛ ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهم عن البغي، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبُّوه على المرسلين. ولكن القوم لم يمهلوه حتى قتلوه، فكان جزاؤه الجنة، وكان جزاء قومه أن أهلكوا بالصيحة ؛ كما أخبر الله تعالى عنهم في نهاية القصة.
وقد ذكر كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم– عليه السلام– كما نصَّ عليه قتادة وغيره، ولم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غير هذا القول. وفي ذلك نظر من وجوه:
أحدهما: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء الرسل كانوا رسل الله عز وجل، لا من جهة المسيح عليه السلام ؛ كما قال الله تعالى:﴿ إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما * فَعَزَّزْنا بِثالثٍ فَقالُوا إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾، إلى أن قالوا:﴿ رَبُّنا يَعْلَمُ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَما عَلَيْنا إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ ﴾. ولو كان هؤلاء من الحواريين، لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح– عليه السلام– والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح، لما قالوا لهم:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾.
والثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وأن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت أنطاكية عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركةٌ ؛ وهنَّ: القدس ؛ لأنها بلد المسيح. وأنطاكية ؛ لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها. والإسكندرية ؛ لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة، والمطارنة، والأساقفة، والقساوسة، والشمامسة، والرهابين. ثم رومية ؛ لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم، وأطَّده. ولما ابتنى القسطنطينية، نقلوا البترك من رومية إليها، كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم ؛ كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين. فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، والله أعلم.
الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين كانت بين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري– رضي الله عنه– وغير واحد من السلف، أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة، لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى:﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾(القصص: 43). فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية.
ثانيًا- وتبدأ قصة هذا المثل بقول الله عز وجل:﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، وهو خطاب من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، يأمره فيه بأن يضرب لقومه مثلاً بأصحاب هذه القرية ؛ إذ جاءهم المرسلون، فكذبوهم، فأنزل الله تعالى عليهم عذابه. و﴿ أَصْحابَ الْقَرْيَةِ ﴾ بدل من ﴿ مَثَلاً ﴾، وتفسير له. و﴿ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ بدل من ﴿ أَصْحابَ الْقَرْيَةِ ﴾.
وقال تعالى:﴿ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، بتأنيث الضمير، ولم يقل:﴿ جَاءَهَمُ الْمُرْسَلُونَ ﴾، بتذكيره، مع أنه المراد، إشارة إلى أن المرسلين جاؤوهم في مقرِّهم. وفيه إشارة أيضًا إلى أن هذه القرية كانت من القرى الكبيرة المشهورة في غابر الأزمنة.
وليس في ذلك ما يدل على أن هذه القرية هي أنطاكية، أو يشير إلى أن هؤلاء المرسلين هم رسل المسيح- عليه السلام- كما ذكر أكثر المفسرين من السلف ؛ لأن قصة هذه القرية وأهلها كانت قبل المسيح– عليه السلام– ثم بعد هذا عمرت أنطاكية، وبقي أهلها على شركهم، إلى أن جاءهم من جاءهم من الحواريين، فآمنوا بالمسيح– عليه السلام– على أيديهم، ودخلوا دينه. وقد سبق أن ذكرنا أن أنطاكية كانت أول المدائن الأربعة الكبار التي آمن أهلها بالمسيح عليه السلام. وكان ذلك بعد رفعه إلى السماء ؛ ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المرسلين المذكورين في هذه القصة أنهم رسل المسيح، وأنهم من الحواريين.
وقال تعالى:﴿ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، ولم يقل:﴿ أَتَاهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ ؛ لأن المجيء أعمُّ من الإتيان، ويقال: اعتبارًا بحصول الشيء. أما الإتيان فهو المجيء بسهولة، وقد يقال باعتبار القصد، وإن لم يكن منه الحصول. ويقال كل منهما في الأعيان والمعاني، ولِمَا يكون مجيئه بالذات، وبالأمر. ويقال المجيء لمن قصد مكانًا، أو عملاً، أو زمانًا.
والفرق بين قولنا:« جاء فلان »، و« أتى فلان »: أن الأول كلام تام لا يحتاج إلى صلة، وأن الثاني يقتضي مجيئه بشيء ؛ ولهذا يقال:« جاء فلان نفسُه »، ولا يقال:« أتى فلان نفسُه ». ثم كثر ذلك حتى استعمل أحد اللفظين في موضع الآخر.
ومجيء المرسلين- هنا- هو مجيء بالأمر، قُصِد به المكان. ومثله في ذلك قول الله تعالى:﴿ وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾(هود: 77). وفي ذلك دليل آخر على أن المرسلين كانوا رسل الله تعالى، ولم يكونوا رسل المسيح عليه السلام.
وقوله تعالى:﴿ إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما ﴾ بدل من قوله:﴿ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾. أي: إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا إليهم اثنين منهم. و﴿ إِذْ ﴾ لفظ يعبَّر به عما مضى من الزمان. وقال تعالى:﴿ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ ﴾، ولم يقل:﴿ أَرْسَلْنا إِلَيْهِا ﴾ ؛ كما قال من قبل:﴿ إذ جاءها ﴾. ولعل السر في ذلك أن الإرسال حقيقة ؛ إنما يكون إليهم، لا إليها، بخلاف المجيء. وأيضا التعقيب عليه بقوله تعالى:﴿ فكذبوهما ﴾ أظهر.
والفاء في قوله تعالى:﴿ فَعَزَّزْنا بِثالثٍ ﴾ عاطفة للتعقيب أيضًا. ونُزِّلَ الفعلُ منزلة اللازم لمعنى لطيف، وهو أن المقصود من إرسال الرسل هو نصرة الحق، لا نصرة الرسل ؛ ولهذا لا يصح تفسيره بقولهم: فَعَزَّزْناهما. وقرأ عاصم في رواية أبى بكر والمفضل عن عاصم:﴿ فعزَزنا ﴾، خفيفة الزاي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم:﴿ فعزَّزنا ﴾، مشددة الزاي. وقيل: المعنى على قراءة التشديد: قوَّينا وشدَّدنا. يقال: تعزَّز لحم الناقة، إذا صلب. والمعنى على قراءة التخفيف: غلبنا وقهرنا. ومنه قوله تعالى:﴿ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴾(ص: 23). أي: غلبني وقهرني.
والحقيقة أن المعنى على القراءتين يرجع إلى معنى واحد ؛ لأن الغالب القاهر لا يكون غالبًا وقاهرًا، إلا إذا كان قويًّا شديدًا، والله تعالى هو القوي الشديد الغالب لكل شيء، والقاهر لكل الخلق، وهو العزيز الذي ذلَّ لعزته كلُّ عزيز. ويفرَّق بين القراءتين بأن في قراءة التشديد مبالغة لم تكن في قراءة التخفيف.
وقوله تعالى:﴿ فَقالُوا إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ عطف على ما قبله للتفصيل. أي: فقال الثلاثة بعد تكذيب الاثنين، والتعزيز بثالث:﴿ إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾. وقولهم هذا إلى نهاية القصة هو تفصيل تام للقصة بعد إجمال، وبعض تفصيل ؛ فقد ذُكِرَت أولاً إجمالاً بقوله تعالى:﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحابَ الْقَرْيَةِ ﴾، ثم فُصِّلت بعض التفصيل بقوله تعالى:﴿ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إلى قوله:﴿ فَعَزَّزْنا بِثالثٍ ﴾، ثم فُصِّلت تفصيلاً تامًا بقوله تعالى:﴿ قالُوا إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ إلى قوله:﴿ إِنْ كانَتْ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ﴾.
ثالثًا- وهنا اعترض أصحاب القرية على الرسل، فأجابوهم بقولهم:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَكْذِبُونَ ﴾. أي: ليس لكم علينا مزيَّة موجبة لاختصاصكم بما تدَّعونه من أنكم مرسلون، وما أنزل الرحمن شيئًا من وحي، أو غيره على أحد – كما تدَّعون – وما أنتم إلا تكذبون في دعواكم هذه.
ومثل هذا الإنكار والتكذيب هو خطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله، وأنزل عليه الوحي، لا لمن جاء رسولاً من عند رسول ؛ فقد جعلوا كونهم بشرًا مثلهم دليلاً على عدم إرسالهم. وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة ؛ كما أخبر الله تعالى عنهم، فقال:﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ﴾(التغابن: 6). أي: استعجبوا من ذلك، وأنكروه ؛ ولهذا قال هؤلاء الكفرة:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَكْذِبُونَ ﴾.
وقولهم:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ نفي لكونهم رسلاً، وإثبات لكونهم بشرًا مماثلين لهم في حقيقة الذات البشرية على سبيل الحصر. ولفظ البَشَر يستوي فيه الواحد والجمع، وثُنِّيَ في قوله تعالى:﴿ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾(المؤمنون: 47). ويقتضي حسن الهيئة ؛ لأنه مشتق من البشارة، وهي حسن الهيئة. يقال: رجل بِشْر وبشير، إذا كان حسَنَ الهيئة. وكذلك: امرأة بشيرة. وسمِّي البشر: بَشرًا ؛ لأنهم أحسن الحيوان هيئة.
ويجوز أن يقال: إن لفظ البشر، يقتضي الظهور. وسمُّوا: بشرًا ؛ لظهور شأنهم. ومنه قيل لظاهر الجلد: بشرة. فعُبِّر عن الإنسان بالبشر، اعتبارًا بظهور جلده من الشعر، بخلاف الحيوانات التي تكون بشرتها مغطاة بالصوف أو الوَبر أو الشعر.
ويُفَرَّق بين البشر، والحيوان من وجه آخر، وهو: أن البشر مخلوق من جسد ونفس وعقل، والحيوان مخلوق من جسد ونفس فقط. ومن هنا يمكن القول بأن البشر حيوان ناطق، خلافًا للمشهور من قولهم: الإنسان حيوان ناطق ؛ لأن الإنسان يمثل مرحلة متطورة من حياة البشر ؛ ولهذا قيل- كما ذكر الراغب الأصفهاني-: الإنسان مدنيُّ بالطبع. وقال أيضًا: وخُصَّ في القرآن كل موضع اعتُبِر من الإنسان جُثَّتُُهُ وظاهرُه بلفظ البشر ؛ نحو قوله تعالى:﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾(الفرقان: 54). ولما أراد الكفار الغَضَّ من الأنبياء، اعتبروا ذلك فقالوا:﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾(المدثر: 25). وقالوا على سبيل الإنكار:﴿ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَّسُولاً ﴾(الإسراء: 94).
وأما قوله تعالى:﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾(الكهف: 122) فهو تنبيهٌ على أن الناس يتساوون في الذات البشرية. وإنما يتفاضل الناس بما يختصُّون به من المعارف الجليلة، والأعمال الجميلة ؛ ولهذا قال عقبه:﴿ يُوحَى إِلَيَّ ﴾، تنبيهًا على أنه عليه الصلاة والسلام تميَّز بذلك عن غيره. وعلى هذا جاء قولهم:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾.
وأما قولهم:﴿ وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْءٍ ﴾ فهو نَفْيٌ على سبيل الاستغراق والشمول لأن يكون الرحمن أنزل شيئًا من وحي، أو غيره على أحد ؛ كما يدَّعي المرسلون. وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية ؛ لكنهم كانوا ينكرون الرسالة، ويتوسلون بالأصنام.
وكان تخصيص هذا الاسم الجليل:﴿ الرَّحْمنُ ﴾، من بين أسماء الله عز وجل ؛ لزعمهم أن الرحمة تأبى إنزال الوحي، لاستدعائه تكليفًا، لا يعود منه نفع له سبحانه، ولا يتوقف إيصاله تعالى الثواب إلى العبد عليه. وفيه إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن الله تعالى لما كان اسمه الرحمن، وكان إنزال الوحي رحمة، فكيف لا ينزل رحمته، وهو الرحمن ؟
وأما قولهم:﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّ تَكْذِبُونَ ﴾ فهو تصريح بما قصدوه من الجملتين السابقتين. وفي اختيار صيغة المضارع﴿ تَكْذِبُونَ ﴾ على صيغة ﴿ كَاذِبُون ﴾ دلالة على أن تكذيبهم الرسل صفة متجدِّدة فيهم ومستمرة. وهذا ما عبَّر الله تعالى عنه بقوله:﴿ كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴾(المائدة: 70).
رابعًا- فكان جواب المرسلين لهم عن إنكارهم وتكذيبهم أن قالوا:﴿ رَبُّنا يَعْلَمُ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾، وهو جار مجرى القسم في التوكيد، مع ما فيه من تحذيرهم من معارضة علم الله تعالى. استشهدوا به على صدقهم في قولهم:﴿ إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾، وزادوا– هنا- اللام المؤكدة ؛ لِمَا شاهدوا منهم من شدة الإنكار. وذكر العلماء: أن من يستشهد بعلم الله تعالى كاذبًا، يكفر. وليس كذلك الذي يقسم على كذب ؛ لأن من يقول:« يعلم الله »، فيما لا يكون، فقد نسب الله سبحانه إلى الجهل، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.
وفي اختيارهم عنوان الربوبية ﴿ رَبُّنا ﴾ رمز إلى حكمة الإرسال، وهو إشارة إلى الرد على الكفار، حيث قالوا لهم:﴿ ما أَنْتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُنا ﴾ ؛ وذلك لأن الله جل وعلا، إذا كان يعلم أنهم لمرسلون، يكون كقوله سبحانه:﴿ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾(الأنعام: 124). يعني: ربُّنا يعلم بالأمور، لا أنتم ؛ لانتفاء النظر في الآيات عنكم، فاختارنا الله تعالى بعلمه لرسالته. وفي تقديم المسند إليه ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ على المسند ﴿ مُرْسَلُونَ ﴾ تقوية للحكم، أو للحصر.
ثم حصروا مهمتهم بإبلاغ رسالة الله عز وجل بلاغًا مبينًا، فقالوا:﴿ وَما عَلَيْنا إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ ﴾ ؛ وكأنهم قالوا: قد خرجنا عن عهدته، فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جهة ربنا. أو: ما علينا شيء نطالب به من جهتكم، إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور، وقد فعلناه، فأي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا ؟
والمراد بـ﴿ الْبَلاغُ الْمُبينُ ﴾: البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن، فإذا تمَّ ذلك ولم يقبلوا، فإنه يحق هنالك الهلاك. ولكون بلاغهم مبينًا، حَسُنَ منهم الاستشهاد بالعلم، وجاء كلامهم ثانيًا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جدًّا، حيث أتوا بثلاث جمل، وكل منها دال على شدة الإنكار. قال الزمخشري:« فإن قلت: لم قيل:﴿ إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ أولاً، و﴿ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ ثانيًا ؟ قلت: لأن الأول ابتداءُ إخبارٍ، والثاني جوابٌ عن إنكار.. وإنما حسُن منهم هذا الجواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قولهم:﴿ وَما عَلَيْنا إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبينُ ﴾. أي: الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة لصحته ؛ وإلا فلو قال المدعي: والله إني صادق فيما أدعي، ولم يظهر البينة، كان قبيحًا ».
خامسًا– ولما ضاقت الحيل على أصحاب القرية، وعيَّت بهم العلل، قالُوا:﴿ إِنّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ قَالُوْا ﴾. أي: تشاءمنا بكم. قالوا ذلك جَرْيًا على دَيْدَن الجهلة، حيث يتيمَّنون بكل ما يوافق شهواتهم، وإن كان مُسْتجْلِبًا لكل شرٍّ، ويتشاءمون بما لا يوافقها، وإن كان مُسْتتْبِعًا لكل خير. وهذه حجة العاجز الذي لا يستطيع أن يحتج بشيء، فيلوذ إلى اتهام خصومه بالتَّطَيُّر. ونظير ذلك قوله تعالى عن آل فرعون:﴿ فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾(الأعراف: 131). وقال تعالى عن قوم صالح:﴿ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴾(النمل: 47).
وأصل التَّطَيُّر: التفاؤل بالطير البارِحُ والسَّانِحُ، ثم عمَّ. والطير البارِحُ هو الذي يجيء من على يسارك، فإن جاء من على يمينك فهو السَّانِحُ. وكان مَناطُ تطَيُّر الكفرة بالمرسلين مقالتُهم ؛ كما يشعر به قولهم مقسمين:﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا ﴾ عن مقالتكم هذه، ﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾. وهكذا أسفر الباطل عن غُشْمِه في وجه الحق، وأطلق على المرسلين تهديده وبغيه، وعربد في التعبير والتفكير.
وقولهم:﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ ﴾ جواب لقسمهم أكَّدوه باللام، والنون الثقيلة. ويحتمل وجهين من التفسير: أحدهما: الرجم بالقول، وهو أن يكون بالشتم ونحوه. روي عن مجاهد أنه قال: لنشتمنكم. ثم قال: والرجم في القرآن كله: الشتم. والثاني: الرجم بالفعل، وهو أن يكون بالحجارة ونحوها.
أما قولهم:﴿ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾ فعلى الوجه الأول يكون ترقيًّا من الشتم إلى الضرب والإيلام الحِسِّي ؛ كالسلخ والقطع والصلب. وعلى الوجه الثاني يكون المراد منه القتل المتسبِّب عن الرجم بالحجارة. وقيل: هو الحريق. وقيل: عذابٌ، غيرُه تبقى معه الحياة. والمراد: لنقتلنكم بالحجارة، أو لنعذبنكم عذابًا أليمًا، لا يقادر قدره، تتمنون معه القتل.
ولكن الواجب المُلْقَى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمُضِيِّ في الطريق، فيردُّون على الطغاة البغاة، غير آبهين بتهديدهم ووعيدهم، فأجابوهم عن مقالتهم بقولهم:﴿ طائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُسْرِفُونَ ﴾. أي: شؤمكم معكم، وهو إقامتكم على الكفر. وأما نحن فلا شؤم معنا ؛ لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى، وفيه غاية اليمن والخير والبركة. وقيل: حظكم من الخير والشر معكم، ولازم في أعناقكم. قال معناه الضحاك. وقال قتادة: أعمالكم معكم. وقال ابن عباس: معناه: الأرزاق والأقدار تتبعكم. وقال الفراء: رزقكم وعملكم، والمعنى واحد.
وفي لسان العرب لابن منظور:« وطائر الإنسان: ما حصل له في علم الله، ممَّا قدَّر له. ومنه الحديث: بالميمون طائره. أي: بالمبارك حظه. ويجوز أن يكون أصله من الطير السانح والبارح. وقوله عز وجل:﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾(الإسراء: 13)، قيل: حظه. وقيل: عمله. وقال المفسرون: ما عمل من خير أو شر، ألزمناه عنقه، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. والمعنى فيما يرى أهل النظر: أن لكل امرىء الخير والشر قد قضاه الله، فهو لازم عنقه. وإنما قيل للحظ من الخير والشر: طائر ؛ لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطِّيَرَة، على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببًا، فخاطبهم الله بما يستعملون، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يسمونه بالطائر يلزمه ».
وقراءة العامة:﴿ طائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾. وقرىء:﴿ طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾، بياء ساكنة بعد الطاء. قال الزجاج: الطائر والطير بمعنى. وفي القاموس: الطير جمع: طائر، وقد يقع على الواحد. وذُكِر أن الطير لم يقع في القرآن إلا جمعًا ؛ كما في قول الله تعالى:﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ﴾(النور:41). فإذا كان في هذه القراءة كذلك، فلفظ الطائر، وإن كان مفردًا، فهو بالإضافة شامل لكل ما يتطير به، فهو في معنى الجمع، فتكون القراءتان متوافقتين.
وقيل: للشؤم طائر، وطَيْر، وطِيَرة ؛ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها، والتطيُّر ببارحها، ونعيق غرابها، وأخذها ذات اليسار، إذا أثاروها. فسمُّوا الشُّؤْمَ: طيْرًا، وطائرًا، وطِيَرَةً ؛ لتشاؤمهم بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل، ولا يتطير.
وأصل الفَأْل: الكلمة الحسنة يسمعها عليل، فيتأوَّل منها ما يدل على بُرْئِهِ ؛ كأنْ يسمع مناديًا ينادي رجلاً اسمه: سالم، وهو عليل، فيوهمه سلامته من علته. وكذلك المُضِلُّ يسمع رجلاً يقول: يا واجد، فيجد ضالته. والطَّيَرَةُ مضادة للفأْل، وكانت العرب مذهبُها في الفأل والطيرة واحد، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفألَ واستحسنه، وأبطل الطيرة ونهى عنها. فعن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:« الطَّيَرَةُ شرْكٌ، وما منَّا إلا..، ولكن الله يذهبه بالتوكل ». رواه أبو داود والترمذي.
قال ابن الأثير: هكذا جاء الحديث مقطوعًا، ولم يذكر المستثنى. أي: إلا قد يعتريه التَّطَيُّر، ويسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع.. وإنما جعل الطِّيَرَةَ من الشرك ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعًا، أو تدفع عنهم ضرًا، إذا عملوا بموجبه ؛ فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك، وهذا من الشرك الخفيِّ. وقوله:« ولكن الله يذهبه بالتوكل » معناه: أنه إذا خطر له عارضُ التطيُّر، فتوكَّل على الله تعالى وسلَّم إليه، ولم يعمل بذلك الخاطر، غفره له، ولم يؤاخذه به.
وقولهم:﴿ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ﴾ استفهام متضمِّن لمعنى الإنكار، جوابُه محذوفٌ، تقديره:« تطيرتم بنا ». أو قلتم هذا القول. وهو وجوابه المحذوف جوابٌ عن قول الكفرة:﴿ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيمٌ ﴾. والمعنى: أتفعلون ذلك بمن يعظكم، ويدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويبيِّن لكم فساد عقيدتكم، وسوء أفعالكم بالأدلة والبراهين ؟
أما قولهم:﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُسْرِفُونَ ﴾ فيدل على أنهم قوم عادتهم الإسراف في الضلال، ومجاوزة الحد في العصيان، فمن ثَمَّ أتاهم الشؤم، ولم يأتهم من قبل المرسلين، وتذكيرهم ؛ فهو إضراب عما تقتضيه العبارة الشرطية:﴿ أَئِنْ ذُكّرْتُمْ ﴾ من إنكار كون التذكير سببًا للشؤم، وإثبات الإسراف الذي هو أبلغ، وهو جالب الشؤم كله. والإسراف هو الإصرار على الكفر، بعد ظهور الحق بالحجة والبرهان، وتجاوز الحدود في التفكير والتقدير، والمجازة على الموعظة بالتهديد والوعيد، والرد على الدعوة بالرجم والتعذيب ؛ ولذلك وجب إهلاكهم، فإن الكافر مُسِيءٌ، فإذا تمَّ عليه الدليل، وأوضح له السبيل، وبقي مُصِرًّا على الكفر، يكون مُسْرفًا. والمُسْرِفُ هو المجاوز للحدِّ، بحيث يبلغ الضدَّ، وهم كانوا كذلك ؛ لأنهم جزَموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان. ودلَّت الجملة الاسمية على أن الإسراف صفة ثابتة فيهم، ملازمة لهم، لا تفارقهم. تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل، وهي مثل للقلوب التي تحدثت عنها السورة في الجولة الأولى، وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك.
سادسًا– فأما النموذج الآخر الذي اتَّبع الذكر، وخشِي الرحمن بالغيب، فكان له مَسْلَكٌ آخرُ، وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة، ويتمثل في هذا الرجل الذي أخبر الله عنه، وحكى قصته بقوله تعالى:
﴿ وَجاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾
إنه رجل جاء من أقصى المدينة. أي: من أبعد مواضعها، جاء يسعى. أي: يسرع في مشيه ؛ لبعد محله ومزيد اهتمامه، حرصًا منه على نصح قومه، ونُصْرة المرسلين، وتعزيز دعوتهم، ملبيًا نداء الفطرة. والظاهر أن هذا الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان، ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته ؛ ولكنها العقيدة الحيَّة في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها ؛ لينضم إلى موكب المرسلين. وليس مهمًّا بعد ذلك، إن كان هذا الرجل هو حبيب النجار– على ما قيل- أو غيره ؛ لأن معرفة ذلك لا يزيد شيئاً في دلالة القصة وإيحائها.
وقال الله تعالى هنا:﴿ وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى ﴾، وقال في سورة القصص:﴿ وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾(القصص:20)، فقدم الجارَّ والمجرور﴿ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ﴾ على الفاعل ﴿ رَجُل ﴾ في الأول، وأخره عنه في الثاني. وجعل أبو حيان ذلك من التَّفَنُّن في البلاغة. أما الخفاجي فجعل تقديم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم، بيانًا لفضل هذا الرجل ؛ إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم، وأن بعده لم يمنعه عن ذلك ؛ ولذلك عبَّر عن القرية بـ﴿ المدينة ﴾، بعد التعبير عنها بـ﴿ القَرْيَة ﴾ إشارة إلى السعة، وأن الله تعالى يهدي من يشاء سواء قرُب، أو بعُد.
وقيل: قدِّم للاهتمام، حيث تضمَّن الإشارةَ إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة، فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين. وقيل: إنه لو أخِّر، تُوُهِّمَ تعلُّقُه بـ﴿ يَسْعَى ﴾، فلم يفد أنه من أهل المدينة، وأن مسكنه في طرفها، وهو المقصود. وقيل: قدِّم لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل، وإصرارهم على تكذيبهم، فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة تلك القرية، ويبقى مخيلا في فكره: أكانت كلها كذلك، أم كان فيها على خلاف ذلك، بخلاف ما في سورة القصص.
وقوله تعالى:﴿ مِنْ أَقْصَى ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب: أحدها: أنه صفة لـ﴿ رَجُل ﴾، قدِّم عليه، فصار حالاً منه. والثاني: أنه صلة لـ﴿ جَاء ﴾. والثالث: أنه صلة لـ﴿ يَسْعَى ﴾. والأظهر أن يكون صلة لـ﴿ جَاء ﴾. والله أعلم !
وفي الإشارة إلى ﴿ رَجُل ﴾ بلفظ التنكير فائدتان: الأولى: هي تعظيمٌ لشأنه. أي: رجل كامل الرجولة. والثانية: هي بيانٌ لظهور الحق من جانب المرسلين، حيث آمن بدعوتهم رجل من الرجال، لا معرفة لهم به، فلا يقال: إنهم تواطؤا معه.
وفي تقييد مجيء هذا الرجل بصيغة ﴿ يَسْعَى ﴾، دون صيغة ﴿ سَاعِيًا ﴾، إشارة إلى تجدُّد السَّعْيِ منه، واستمراره دون تعب أو ملل. وفيه تَبْصِرةٌ للمؤمنين، وهدايةٌ لهم ؛ ليكونوا في النصح باذلين جهدهم لنصرة الحق أينما كان.
وقد بدأ هذا الرجل خطابه لقومه بقوله:﴿ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾. وهو استئناف بياني وقع جوابًا عن سؤال نشأ من حكاية مجيئه ساعيًا ؛ فكأنه قيل: فماذا قال عند مجيئه ؟ فقيل: قال:﴿ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾. وفيه إشارات لطيفة:
أولها: قوله:﴿ يا قَوْمِ ﴾ ؛ فإنه ينبىء عن إشفاقه عليهم، وإنه لا يريد بهم إلا خيرًا ؛ ولهذا أضافهم إلى نفسه، ولم يقل: يا قومُ ! وأيضًا أراد تأليف قلوبهم، واستمالتها نحو قبول نصيحته.
وثانيها: قوله:﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾ ؛ فإنه جمع بين إظهار نصحه لقومه، وإظهار إيمانه ؛ لأن قوله:﴿ اتَّبِعُوا ﴾ إظهار للنصح، وأن قوله:﴿ الْمُرْسَلينَ ﴾ إظهار لإيمانه.
وثالثها: أنه قدَّم في قوله السابق إظهار النصح على إظهار الإيمان ؛ لأنه كان ساعيًا في النصح. وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل. وقوله تعالى في حقِّه:﴿ رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ يدل على كونه مريدًا للنصح. وممَّا ذكر في حكاية هذا الرجل أنه كان يقول، وهو يقتل: اللهم ! اهدِ قومي. ونظير قوله هذا قول مؤمن آل فرعون:﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾(غافر: 38).
فإن قيل: هذا الرجل قال:﴿ يا قومِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾، ومؤمن آل فرعون قال:﴿ اتَّبِعُونِ ﴾، فما الفرق بين القولين ؟ والجواب: أن مؤمن آل فرعون كان فيهم، واتبع موسى عليه السلام، ونصح قومه مرارًا، فقال: اتبعوني في الإيمان بموسى، واعلموا أنه لو لم يكن خيرًا، لما اخترته لنفسي، وأنتم تعلمون أني اخترته. وأما صاحب ياسين فلم يكن مع قومه، ولم يعلموا شيئًا عن إيمانه، فبدأ نصحه لهم بقوله:﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾ الذين أظهروا لكم الدليل، وأوضحوا لكم السبيل. وبهذا يظهر الفرق بين القولين.
وأما قوله:﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ فليس بتكرير- كما قيل- لقوله:﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾ ؛ لأنه نبَّه أولاً بقوله:﴿ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ ﴾ على موجب الاتباع، وهو كون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي أن يخالف ولا يعصى، وأنه على هداية. ثم نبَّه ثانيًا بقوله﴿ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً ﴾ على انتفاء المانع منه، وهو عدم سؤال الأجر، فلا يريدون منهم دنيا، ولا رياسة. فموجب الاتباع كونهم مهتدين، والمانع منه منتف، وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر.
وقوله:﴿ مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً ﴾ كلمة جامعة في الترغيب فيهم. والمعنى: لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم، وتربحون صحة دينكم. والتعبير عن كونهم مهتدين بالجملة الاسمية ﴿ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ يفيد أن الاهتداء صفة ثابتة فيهم، وملازمة لهم. والجملة حالية، فيها ما يؤكِّد كونَهم لا يسألون الأجر، ولا ما يتبعه من طلب جاه، أو سلطان، أو رياسة، أو نحو ذلك.
سابعًا– وأضاف الرجل المؤمن قائلاً:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ * إِنّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ * إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾، فاحتج على قومه بما ركَّبه الله تعالى في فطر الناس وعقولهم من حسن عبادته وحده، وقبح عبادة غيره ؛ لأنه الفاطر لهم، ولا إله لهم غيره، ولا رب لهم سواه، وهو وحده المستحق للعبادة. وهذا ما قرَّره سبحانه وتعالى في كتابه، ودعا إليه، وأوحى به إلى رسله، فقال جل شأنه:﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾(الأنبياء: 25).
ولهذا افتتح الرسل جميعهم دعوتهم بهذا الأصل الذي يقوم عليه الدين كله ؛ كقول نوح– عليه السلام– لقومه:﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾(الأعراف: 95). وكذلك قال هود، وصالح، وشعيب– عليهم السلام– وغيرهم. كلٌّ كان يقول:﴿ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ﴾، اقتداءً بإمام الحنفاء إبراهيم- عليه السلام- الذي حكى الله تعالى عنه مناظرته لقومه، فقال سبحانه وتعالى:﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾(الزخرف: 26- 28).
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله جل وعلا، وهي البراءة من كل معبود ؛ إلا من الخالق الذي فطر الخلق جميعهم ؛ كما قال صاحب ياسين هنا:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، فأخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه، وهو يريد مناصحتهم تلطفًا بهم، ومداراة لهم ؛ ولأنه أدخل في إمحاض النصح، حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، ونبَّه العقول بذلك على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب، وأن تركها مستهجن، والإخلال بها قبيح ؛ فإن خلق الله تعالى لعباده أصل إنعامه عليهم، ونعمه كلها بعد تابعة لإيجادهم وخلقهم، وقد جبل الله تعالى العقول والفطر على شكر المنعم، ومحبة المحسن.
ثم أقبل هذا الرجل المؤمن على قومه، مخوِّفًا لهم تخويف الناصح، بأن إليه تعالى مرجعهم جميعًا، فيعاقبهم على شركهم. وقدم الجار والمجرور ﴿ إِلَيْهِ ﴾ على الفعل ﴿ِ تُرْجَعُونَ ﴾ ؛ لإفادة الحصر مبالغة في تخويفهم بالرجوع إلى الله الخالق جل وعلا، لا إلى غيره. وإنما قال:﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾، ولم يقل:﴿ وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ ﴾– كما يقتضيه نظم الكلام- تنبيهًا على أنهم هم المعنيون بهذا الخطاب.
ومن الإشارات اللطيفة التي تضمنها هذا الخطاب قوله:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ ﴾ ؛ فهو إشارة إلى عدم المانع من العبادة. أي: ما لي مانع من جانبي يمنعني من عبادته. أما قوله:﴿ الّذي فَطَرَني ﴾ فهو إشارة إلى وجود المقتضي للعبادة، وهو كونه فاطرًا. وقدَّم بيان عدم المانع من العبادة على بيان وجود المقتضي لها، لوجود الحاجة إلى الأول، وظهور الثاني.
وفي العدول عن مخاطبة قومه إلى مخاطبة نفسه لطيفة أخرى ؛ وهي أنه لو قال:﴿ وَمَا لَكُمْ لا تَعْبُدُونَ الَّذي فَطَرَكُمْ ﴾، جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة على امتناعهم عن عبادة فاطرهم ؛ كما فهِم ذلك من قول نوح- عليه السلام- لقومه:﴿ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾( نوح:13) ؛ ولهذا قال:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ ﴾، مشيرًا إلى بيان عدم المانع.
والفرق بين القولين: أن نوحًا- عليه السلام- كان داعيًا لقومه. أما صاحب ياسين فإنه كان مَدعوًّا إلى الإيمان من قبل المرسلين، فقال:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني ﴾، وقد طُلِبَ مني ذلك ؟ أي: لا يوجد عندي مانع يمنعني من الإيمان. فاختلف لذلك وجها الكلام.
قال ابن قيِّم الجوزيَّة:« فتأمل هذا الخطاب، كيف تجد تحته– على وجازته- أشرف معنى وأجله، وهو أن كونه سبحانه فاطرًا لعباده يقتضي عبادتهم له، وأن من كان مفطورًا مخلوقًا، فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ؛ ولا سيما إذا كان مرده إليه، كما كان مبتدأه منه سبحانه. وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له ».
وهذا النوع من الخطاب يسميه علماء البيان: التعريض. ويعرفونه بأنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم. وإنما سمَّوْه: تعريضًا ؛ لأن المعنى باعتباره يُفْهَمُ من عرَض اللفظ. يقال: نظر إليه بعَرَض وجهه. أي: بجانبه. ويُسَمَّى: تلويحًا أيضًا ؛ لأن المتكلم يلوِّح منه للسامع ما يريده ؛ كقول تعالى يحكي قول إبراهيم عليه السلام:﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ﴾(الأنبياء: 63)، جوابًا لقولهم:﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾(الأنبياء: 62) ؛ لأن غرضه بقوله:﴿ فَاسْأَلُوهُمْ ﴾ الاستهزاء بهم، وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم، إذا سألوا. ولم يرد بقوله:﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ نسْبةَ الفعل الصادر عنه إلى الصنم، فدلالة هذا الكلام عجْزُ كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة.
ومن أقسام هذا النوع من الخطاب: أن يخاطب الشخص، والمراد غيره ؛ سواء كان الخطاب مع نفسه، أو غيره ؛ كقوله تعالى:﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾(الزمر: 65)، وقوله تعالى:﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم ﴾(الرعد: 37). فالخطاب في هاتين الآيتين للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد به قومه، تعريضًا بأنهم أشركروا، واتَّبعوا أهواءهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذلك، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادِّعاء.
وعلى هذا ورد قوله تعالى:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني ﴾، والمراد: مالكم لا تعبدون الذي فطركم. هذا هو أصل الكلام ؛ ولكنه أبرزه في معرض المناصحة لنفسه، وهو يريد مناصحتهم ؛ ليتلطف بهم، ويريهم أنه لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. ثم لما انقضى غرضه من ذلك، قال:﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ؛ ليدل على ما كان من أصل الكلام، ومقتضيًا له. ولولا التعريض، لكان المناسب أن يقول:﴿ وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ ﴾. وهذا وجه حَسَنٌ من أوجه الخطاب في القرآن. ووَجْهُ حُسْنِهِ ظاهرٌ ؛ لأنه يتضمَّن إعلامَ السامع على صورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب المُنكَر ؛ وكأنه لم يَعْنِِه هو. ثم هو أعلى في محاسن الأخلاق، وأقرب للقَبُول، وأدْعَى للتواضع. والكلام ممَّن هو رب العالمين، نزَّله بلغتهم، وتعليمًا للذين يعقلون.
وقال هنا:﴿ فَطَرَني ﴾، ولم يقل:﴿ خَلَقَني ﴾ ؛ لأنه أنسب في مقام الحِجَاج ؛ لإثبات إلهية الخالق جل وعلا ووحدانيته، وهو من قولهم: فطَر الشيءَ، إذا ابتدأ إنشاءَه وفتحَه. وأصل الفَطْر: الشَّقُّ طولاً. ومنه قوله تعالى:﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾(الأنعام: 14). أي: مبدعهما ابتداءً على غير مثال سابق. وليس كذلك قولنا:« خالق السموات والأرض » ؛ لأن الأصل في الخَلْق أن يكون من شيء ؛ كقوله تعالى:﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾(الروم: 21). وقد يكون من لا شيء كَالفَطْر ؛ نحو قوله تعالى:﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ ﴾(آل عمران: 190).
وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:« ما كنت أدري ما ﴿ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾، حتى اختصم إليَّ أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. أي: أنا ابتدأت حفرها ». وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي، يقول:« أنا أول من فطر هذا. أي: أول من ابتدأه ».
ثم احتج عليهم بما تَقِرٌّ به عقولهم وفطرهم من قبْح عبادة غيره، وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره، فقال:﴿ أأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ﴾، فبيَّن أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى باطلة، وأن عبادتها باطلة ؛ لأن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه. فإذا أراده الرحمن الذي فطره بضُرٍّ، لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذه بها من ذلك الضُّرّ، وليس لهذه الآلهة من الجاه والمكانة عند الله تعالى ما يشفع له إليه ؛ ليتخلص من ذلك الضُّرِّ. فبأي وجه من الوجوه تستحق هذه الآلهة الباطلة العبادة ؟
وقوله:﴿ أأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ إنكارٌ لاتخاذ جنس الآلهة على الإطلاق، ونَفْيٌ لوجود إله غير الله جل وعلا ؛ كما كان قوله:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ ﴾ إثباتًا لوجود الله عز وجل. ولا يتم التوحيد، ويتحقق معنى ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ إلا بهما. وهذا تعريض بقومه الذين اتخذوا آلهة، وعبدوها من دون الله سبحانه، وفيه من تحميق من يعبد الأصنام ما فيه. وفي الآية أيضًا– كما قال الفخر الرازي- لطائف:
الأولى: ذِكْرُهُ على طريق الاستفهام، فيه معنى وضوح الأمر ؛ وذلك أن من أخبر عن شيء، فقال مثلاً: لا أتخذ، يصِحُّ من السامع أن يقول له: لِمَ لا تتخذ ؟ فيسأله عن السبب. فإذا قال: أأتخذ ؟ يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي يطالب به عند الإخبار ؛ كأنه يقول: استشرتك فدلني، والمستشار يتفكر ؛ فكأنه يقول: تفكر في الأمر، تفهم من غير إخبار مني.
الثانية: بيَّن أن ﴿ مِنْ دُونِهِ ﴾ لا تجوز عبادته. فإن عبد غير الله، وجب عبادة كل شيء مشارك للمعبود الذي اتخذ غير الله ؛ لأن الكل محتاج مفتقر حادث. فلو قال: لا أتخذ آلهة، لقيل له: ذلك يختلف، إن اتخذت إلهًا غير الذي فطرك، ويلزمك عقلاً أن تتخذ آلهة، لا حصر لها. وإن كان إلهك ربك وخالقك، فلا يجوز أن تتخذ آلهة.
الثالثة: قوله:﴿ أأَتَّخِذُ ﴾ إشارة إلى أن غيره ليس بإله ؛ لأن المُتَّخذَ لا يكون إلهًا ؛ ولهذا قال تعالى:﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ﴾(الإسراء: 111) ؛ لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة، ولا يجوز ؛ وإنما النصارى قالوا: تبنَّى الله عيسى وسمَّاه: ولدًا، فقال:﴿ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ﴾.
وأما قوله:﴿ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ﴾ فهو جملة شرطية استئنافية، سيقت لتعليل النفي المذكور. وجعلها صفة لـ﴿ آلِهَةً ﴾– كما ذهب إليه بعض المفسرين- ربما يوهم أن هناك آلهة ليست كذلك.
وقال:﴿ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ﴾، ولم يقل:﴿ إنْ يُردِ الرَّحْمنُ بي ضُرًّا ﴾، فأدخل الباء على الضرِّ، وقدَّم المفعول ؛ لأن المقصود هو بيان كونه تحت تصرف الرحمن، يقلبه كيف يشاء، في البؤس، والرخاء، وليس الضرُّ بمقصود بيانه. كيف، والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة، بناء على إيمانه بحكم وعد الله تعالى ؟ ويؤيِّد هذا قوله من قبل:﴿ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾، حيث جعل نفسه مفعول الفطرة ؛ فكذلك جعلها مفعول الإرادة. وقرىء:﴿ إنْ يَردْن ﴾، بفتح الياء، على معنى: إن يوردني ضرًّا. أي: يجعلني موردًا للضرِّ.
وقال في الزمر:﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ ﴾(الزمر: 38)، وقال هنا:﴿ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ ﴾، فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي، وذكر المريد باسم الله هناك، واختيار صيغة المضارع، وذكر المريد باسم الرحمن هنا ؟ ويجاب عن الأول بأن التعليق الشرطي في الجمل الشرطية نوعان: خبري، ووعدي.
أما الخبري فهو الذي يكون مضَمَّنًا جوابًا لسؤال سائل: هل وقع كذا ؟ أو يكون ردًّا لقول قائل: قد وقع كذا. فهذا يقتضي المضي لفظًا ومعنى، ولا يصح فيه الاستقبال بحال ؛ ومنه قوله تعالى:﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾(الزمر: 38).
وأما الوعدي فالغرض منه هو التعليق المحض المجرد من أي معنى آخر. وهذا يقتضي الاستقبال، ولا يصلح فيه المضي ؛ ومنه قوله تعالى:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ﴾( يس: 22- 23).
ويجاب عن الثاني بأن لفظ الجلالة ﴿ اللَّهِ ﴾، ولفظ الرحمة ﴿ الرَّحْمنُ ﴾ هما الاسمان المختصان بواجب الوجود من بين أسمائه الحسنى ؛ كما أشار إلى ذلك جل وعلا بقوله:﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾(الإسراء: 110)، والأول هو اسمه الذي يدل على هيبته وعظمته. والثاني هو صفته التي تدل على رأفته ورحمته.
فلما أخبر الله تعالى عن نفسه في سورة الزُّمَر بأنه عزيز ذو انتقام بقوله:﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴾(الزمر: 37)، ثم ذكر ما يدل على عظمته بقوله:﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾(الزمر: 38)، ناسب ذلك ذكر الاسم المنبىء عن العظمة ؛ وهو﴿ اللَّهِ ﴾ جل وعلا.
ولما أخبر سبحانه عن صاحب ياسين بأنه أظهر في دعوته لقومه إلى عبادة الله تلطفه بهم، ومداراته لهم، وإشفاقه عليهم بقوله:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾(يس: 22)، ناسب ذلك ذكر الاسم المنبىء عن الرحمة ؛ وهو﴿ الرَّحْمَنَ ﴾ المتَّصف بالرحمة على وجه التمام والكمال. وكيف لا يذكر هذا الاسم الجليل، وقد سبقه الكفرة إلى ذكره عندما قالوا:﴿ وَما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَىْءٍ ﴾ ؟ فهو أولى بذكره منهم !
ثم قال:﴿ لا تُغْنِ عَنّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ﴾ على ترتيب ما يقع من العقلاء، فذكر الشفاعة أولاً، ثم ذكر الإنقاذ ثانيًا ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضُّرِّ عن شخص أضرَّ به شخص آخر، يدفع بالوجه الأحسن، فيشفع أولاً. فإن لم يقبل، لجأ إلى إنقاذه بما أوتي من قوة. وهذه الآلهة لا تنفع شيئًا من النفع عند الرحمن، وليست لديها القدرة على الإنقاذ من ذلك الضر بالنصرة والمظاهرة، إن أخفقت في شفاعتها. وهو ترَقٍّ من الأدنى إلى الأعلى، بدأ أولاً: بنفي الجاه، وذكر ثانيًا: انتفاء القدرة، وعبَّر عنه بانتماء الإنقاذ ؛ لأنه نتيجته. ونفى ذلك بـ﴿ لا ﴾ الدالة على نفي ما بعدها نفيًا شاملاً، لا أمل معه أبدًا في حصول ما ذكر. وإنما ذكر الشفاعة والإنقاذ ؛ لأنهم كانوا يتخذون الآلهة شفعاء ووسائط عند الله سبحانه ؛ كما قال تعالى:﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾(يونس: 18).
وقد ثبت بهذه الآيات أن الله تعالى معبود من كل وجه: فالبنظر إلى جانبه سبحانه فهو فاطرٌ، وربُّ مالكٌ، يستحق العبادة ؛ سواء أحْسَنَ، أم لم يُحْسِنْ. وبالنظر إلى إحسانه فهو رحمن. وبالنظر إلى الخوف والرجاء فهو يدفع الضر. وثبت بذلك أن غير الله تعالى لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه ؛ لأن أدنى مراتب المعبود أن يُعَدَّ ليوم كريهة يُرجَى منه فيه دفع ما يقع من ضُرٍّ بالعابد في ذلك اليوم. وغير الله تعالى ليست لديه القدرة على دفع شيء إلا بإذنه وإرادته ؛ كما قال سبحانه:﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾(البقرة: 255). فمن يعبد من دون الله آلهة هذا شأنها، يكون في ضلال ظاهر بيِّن، لا يخفي على أحد من ذوي العقول والبصائر. وهذا ما أراده بقوله:﴿ إِنّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾.
وبعد أن تحدث بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة، أعلن قراره بالإيمان في وجه قومه المكذبين المهددين المتوعدين، غيرَ مُبالٍ بالعواقب ؛ لأن صوت الفطرة في قلبه كان أقوى من كل تهديد، ومن كل تكذيب ؛ وذلك قوله:﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾. وهو عبارة عن جملتين: الأولى خبرية لفظًا ومعنى. والثانية إنشائية معطوفة على الأولى.
وقيل في تأكيد الأولى: إنهم لم يعلموا من كلامه أنه آمن ؛ بل تردَّدوا في ذلك، لما سمعوا منه ما سمعوا. قال كعب ووهب: إنما قال ذلك لقومه::﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ ﴾ الذي كفرتم به. وقيل: إنه لما قال لقومه:﴿ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً ﴾، رفعوه إلى الملك، وقالوا: قد تبعت عدونا، فطَوَّل الكلام معهم ؛ ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل إلى أن قال: ﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾، فوثبوا عليه، فقتلوه.
قال ابن عباس وغيره: خاطب بها قومه، على جهة المبالغة والتنبيه. وقال ابن مسعود: خاطب بها الرسل، على جهة الاستشهاد بهم والاستحفاظ للأمر عندهم. فعلى هذا يكون معنى ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾: فاشهدوا. أي: كونوا شهودي بالإيمان. والصواب هو القول الأول.. والله تعالى أعلم !
وقد يقال: لم قال هنا:﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ ﴾، ولم يقل:﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبِّي ﴾ ؛ كما قال من قبل:﴿ وَماليَ لا أَعْبُدُ الّذي فَطَرَني ﴾ ؟ ويجاب عن ذلك بأنه لما قال هنا:﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبّكُمْ ﴾، فُهِم منه أنه قال لهم: ربي وربكم واحد، وهو الذي فطرني وفطركم. وفي ذلك تحقيق للحق، وتنبيه على بطلان ما هم عليه من الآلهة أربابًا من دون الله تعالى. وأيضًا لو أنه قال:﴿ إِنّي آمَنْتُ بِرَبِّي ﴾، لكان جواب قومه عليه: ونحن آمنا بربنا. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام:﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾(الشورى: 15).
وفي قوله:﴿ فَاسْمَعُون ﴾– كما ذكر الفخر الرازي- فوائد:
أحدها: أنه كلامُ مُتَرَوٍّ متفكِّر. فإن المتكلم، إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين، يتفكَّر.
وثانيها: أنه ينبه القوم، ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت، حتى لا تقولوا: لِمَ أخفيت عنا أمرك ؟ ولو أظهرته، لاتبعناك.
وثالثها: أن يكون المراد: السماع الذي بمعنى القَبول. يقول القائل: نصحته، فسمع قولي. أي: قبله.
وقرأ الجمهور:﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾، بكسر النون، على نية الياء. وروى أبو بكر عن عاصم:﴿ فَاسْمَعُونَ ﴾، بفتح النون. قال أبو حاتم: هذا خطأ، لا يجوز؛ لأنه أمر: فإما حذف النون، وإما كسرها على نية الياء. وأثبت الياء يعقوب، فقرأ:﴿ فَاسْمَعُونِي ﴾.
ثامنًا– ويسدل بعد ذلك الستار على الدنيا وما فيها من حطام، وعلى القوم وما هم فيه من كبر وعناد، وما هم عليه من كفر وشرك، ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء، وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة، ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق، ومن تهديد البغي إلى سلام النعيم، ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين. ونرى هذا الرجل، الذي جهر بكلمة الحق، وقذف بها في وجوه قومه الطغاة، نراه في الجنة ينعم بما ادَّخر الله له فيها من كرامة، تليق بمقام المؤمنين المخلصين الصابرين، ونسمعه، وهو يتمنى أن يعلم قومه بما غفر له ربه، وجعله من عباده المكرمين؛ وذلك قوله تعالى:
﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ * بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمينَ ﴾
وظاهر قوله تعالى:﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ ﴾ أنه إِذْنٌ له بدخول الجنة حقيقة، إكرامًا له بعد أن قتله قومه ؛ كسائر الشهداء. قال قتادة: أدخله الله الجنة، وهو فيها حي يرزق. وقيل: معناه: وجبت لك الجنة، فهو خبر بأنه قد استحق دخولها. ولا يكون ذلك إلا بعد البعث. ولم يأت في القرآن أنه قتل ؛ ولهذا قال الحسن: لما أراد قومه قتله، رفعه الله إلى السماء، فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السموات، وهلاك الجنة، فإذا أعاد الله الجنة، دخلها. وجمهور المفسرين على القول بأنه قتل. وذكر ابن عطيَّة أن الأحاديث والروايات تواترت بأنهم قتلوه. وقول قتادة الذي تقدم ذكره، ليس نصًّا في نفي القتل.
وقال تعالى:﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ ﴾، ولم يقل:﴿ قِيلَ لَهُ ادْخُلِ الجَنَّةَ ﴾ ؛ لأن الغرض من ذلك هو بيان المقول، لا المقول له، لظهوره وللمبالغة في المسارعة إلى بيانه. وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا. وفيه – أيضًا- دلالة على أن الجنة مخلوقة.
والجملة استئناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك، وقع جوابًا عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقاله ؛ كأنه قيل: كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلُّب في دينه، والتسخِّي بروحه لوجهه تعالى ؟ فقيل:﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجَنَّةَ ﴾. وكذلك قوله تعالى:﴿ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ ﴾ هو استئناف آخر لبيان حاله، وقع جوابًا عن سؤال نشأ من حكاية حاله ؛ كأنه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة ؟ فقيل:﴿ قالَ يا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ ﴾:﴿ بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمينَ ﴾.
وفى معنى تمنِّيه قولان: حدهما أنه تمنى أن يعلم قومه بحاله ؛ ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته، إرغامًا لهم. والثاني: أنه تمنى أن يعلموا بذلك ؛ ليؤمنوا مثل إيمانه، ويصيروا إلى مثل حاله التي صار إليها.
وقوله:﴿ بِما غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمينَ ﴾ إشارة إلى أن العمل الصالح يوجب أمرين: أولهما الغفران. وثانيهما: الإكرام ؛ كما قال تعالى:﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾(سبأ: 4). وهذا الرجل كان من المؤمنين الصالحين ؛ ولذلك وجبت له المغفرة، ووجب له الإكرام.
و﴿ مَا ﴾ في قوله:﴿ بِما غَفَرَ لي رَبّي ﴾ إما موصولة، وإما مصدرية. وكونها موصولة أنسب وأجود ؛ لإبهامها ووقوعها على الجنس العام، وهو– هنا- جنس الذنوب. ولو جعلت مصدرية، لما دلت على هذا المعنى. ولا يجوز تفسيرها– إن كانت موصولة– بـ﴿ الَّذِي ﴾ ؛ لما يُرَاد به من التعيين لِمَا يعقل، والاختصاص به دون غيره ؛ ولأنه لا يقع على الجنس العام، كما تقع عليه ﴿ مَا ﴾. وهذا هو أحد أوجه الفروق الدقيقة بين معنى ﴿ مَا ﴾ هذه، ومعنى ﴿ الَّذِي ﴾.. هكذا كان جزاء المؤمنين الصادقين: غفران من جنس الذنوب كلها، وإكرام يجعل صاحبه مستغنيًا عن كل أحد، ويدفع جميع حاجاته بنفسه.
تاسعًا– أما الكفرة الطغاة فقد كانوا أهون على الله تعالى من أن يهلكهم بأن ينزل عليهم جندًا من السماء ؛ كالحجارة، والريح، وغير ذلك ؛ كما فعل بكفار مكة يوم بدر والخندق. وما كان ليرسل ذلك على الأمم قبلهم، إذا أراد إهلاكهم ؛ بل يبعث عليهم عذابًا يدمرهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى:
﴿ وَما أَنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنّا مُنْزِلينَ ﴾
وهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه توعُّد لقريش أن يصيبهم ما أصاب قوم هذا الرجل من الهلاك ؛ إذ هذا هو المروِّع لهم من هذا المثل. فنفى الله عز وجل أن يكون أنزل على قوم هذا الرجل، من بعد قتله جندًا من السماء ؛ ليهلكهم، ولله ﴿ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾(الفتح: 4، و 7). وما صَحَّ في حكمه الله جل وعلا أن ينزل في إهلاكهم جندًا من جنوده التي لا يعلمها إلا هو ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾(المدّثر: 31). فالأمر عند الله تعالى أهون من ذلك بكثير وأيسر.
فـ﴿ مَا ﴾ الأولى نفيٌ لإنزال الجند من السماء على أولئك القوم، أريد به الاستغراق والشمول لكل فرد من أفراد الجنس ؛ ولهذا أدخلت ﴿ مِنْ ﴾ على لفظ ﴿ جُنْدٍ ﴾ في قوله:﴿ مِنْ جُنْدٍ ﴾. و﴿ مَا ﴾ الثانية توكيدٌ للأولى على سبيل الجحد.. والسر في هذا النفي وتأكيده هو أنه تعالى قدَّر لكل شيء سببًا، وأجرى سنَّته في هلاك من أهلك من الأمم المكذبة على بعض الوجوه دون بعض ؛ حيث أهلك بعضهم بالحاصب، وبعضهم بالصيحة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالإغراق، وبعضهم بالمطر ؛ كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله:
﴿ فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾(العنكبوت: 40) – ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (الأعراف: 84) – ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴾ (الشعراء: 173، والنمل: 58).
هذه هي ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ﴾(الأحزاب: 62)، ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً ﴾(فاطر: 43).
ولم يجعل سبحانه وتعالى إنزال الجند من السماء في إهلاك المكذبين إلا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم في الانتصار له من قومه، خلافًا لهؤلاء القوم الذين عاجلهم بالهلاك، إن كانت إلا صيْحَة واحدة، أخمدت أنفاسهم، وجعلتهم أثرًا بعد عين:
﴿ إِِنْ كانَتْ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ﴾
قال المفسرون: أرسل الله تعالى عليهم جبريل– عليه السلام– فأخذ بعضادتي باب بلدهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة، فإذا هم صرعى بائدون عن آخرهم، لم يبق فيهم روح تتردد في جسد. وفي ذلك إشارة إلى تهوين شأنهم، وتصغير قدرهم، وإيماء إلى تفخيم شأن الرسول.
وقراءة الجمهور:﴿ إِِنْ كانَتْ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً ﴾، بنصب ﴿ صَيْحَةً ﴾، على الخبر. أي: ما كان عذابهم إلا صيحة واحدة. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ومعاذ بن الحارث القارىء برفع ﴿ صَيْحَة ﴾، على أنها فاعل لفعل الكون. والمعنى: ما وقعت، أو حدثت إلا صيحة واحدة.
وضعَّف أبو حاتم، وكثير من النحويين هذه القراءة، بسبب لحوق تاء التأنيث ؛ إذ الأصل عندهم أن لا يلحق ﴿ كانَ ﴾ تاء التأنيث ؛ لأن الفعل إذا كان مسندًا إلى ما بعد ﴿ إِلاّ ﴾ من المؤنث، لم تلحق العلامة للتأنيث، فيقال: ما قام إلا هند. ولا يجوز: ما قامت إلا هند، عند البصريين إلا في الشعر، وجوزه بعضهم في الكلام على قلة. وقرأ ابن مسعود، وعبد الرحمن بن الأسود:﴿ إِلاّ زقْيَةً واحِدَةً ﴾، بدلاً من:﴿ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً ﴾، من زقا الديك، أو الطائر، إذا صاح.
و﴿ إِذا ﴾ في قوله تعالى:﴿ فَإِذا هُمْ خامِدُونَ ﴾ هي الفجائية. أي: فاجأهم الخمود إثر الصيحة مباشرة. و﴿ خامِدُونَ ﴾: ساكنون موتى، لاطئون بالأرض. كنَّى به عن سكونهم بعد حياتهم تشبيهًا بالرماد الذي خمدت ناره وطفئت بعد توقُّدها ؛ كما قال لبيد:
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه ** يحور رمادًا بعد إذ هو طالع
ويسدل الستار على مشهد هؤلاء القوم البائس المهين الذليل. وفي هذه اللحظة الحاسمة التي يختار فيها الإنسان الضلالة على الهداية والباطل على الحقّ، يصِحُّ أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بقوله:
﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ﴾
وهو تذييل من كلام الله تعالى واقع موقع الرثاء للأقوام المكذبين للرسل، شامل لقوم هذا الرجل المقصودين بسَوْق المثل السابق، واطراد هذا السَنن القبيح فيهم. وقوله تعالى:﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ نداء للحسرة عليهم ؛ كأنما قيل لها: تعالَيْ يا حسرة ! فهذه من أحوالك التي حقُّك أن تحضري فيها، وهي حال استهزائهم بالرسل. والمعنى: أنهم أحقاء بأن يتحسَّر عليهم المتحسِّرون، ويتلهَّف على حالهم المتلهِّفون. وأجيز أن يكون ذلك من الله تعالى على سبيل الاستعارة، تعظيمًا للأمر وتهويلاً له. وحينئذٍ يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله تعالى ؛ كالضحك والنسيان والسخر والتعجب والتمني. ويعضِّد ذلك قراءة من قرأ:﴿ يَا حَسْرَتَا ﴾ ؛ لأن المعنى عليها: يا حسرتي.
وقرأ ابن عباس، والضحاك، وعلي بن الحسين، ومجاهد، وأبي بن كعب:﴿ يَا حَسْرَةَ الْعِبَادِ ﴾، على الإضافة إليهم، لاختصاصها بهم، من حيث إنها موجهة إليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:« يا ويلا العباد »، وهو قول حسن مع قراءته. وقرأ الأعرج بن جندب، وأبو الزناد:﴿ يَا حَسْرَهْ على الْعِبَادِ ﴾، بالوقف على الهاء، إجراء للوصل مجرى الوقف ؛ وذلك للحرص على بيان معنى التحسر، وتقريره للنفس. والنطق بالهاء في مثل هذا أبلغ في التشفيق وهز النفس ؛ كقولهم: أُوْه، ونحوه.
وتنكير الحسرة في قراءة الجمهور:﴿ يَا حَسْرَةً ﴾ للتكثير. والألف واللام في ﴿ الْعِبَادِ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: للمعهود، وهم الذين أخذتهم الصيحة، فيا حسرة عليهم. وثانيهما: لتعريف الجنس المستعمل في الاستغراق، وهو استغراق ادعائي، رُوعِيَ فيه حال الأغلب على الأمم التي يأتيها رسول لعدم الاعتداء في هذا المقام بقلة الذين صدَّقوا الرسل ونصروهم ؛ فكأنَّهم كلهم قد كذبوا.
والحسرة: التلهفات التي تترك صاحبها حسيرًا. أي: شديد الندم والتلهف على نفع فائت. وحرف النداء هنا لمجرد التنبيه على خطر ما بعده ؛ ليصغي إليه السامع. وكثُر دخوله في الجمل المقصود منها إنشاء معنى في نفس المتكلم دون الإِخبار، فيكون اقتران ذلك الإِنشاء بحرف التنبيه إعلانًا بما في نفس المتكلم من مدلول الإِنشاء ؛ كقولهم: يا خيبة. يا لعنة. يا ويلي. يا فرحي. يا ليتني، ونحو ذلك قوله تعالى:﴿ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾(النساء: 73). وقوله تعالى:﴿ يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً ﴾(الفرقان: 28).
و﴿ الْعِبَادِ ﴾ اسم للناس، وهو جمع: عبد. والعبد هو الممْلوك. وجميع الناس عبيد لله تعالى ؛ لأنه خالقهم والمتصرف فيهم. قال تعالى:﴿ رزقاً للعباد ﴾. ويجمع على: عبيد، وعباد. وغلب الجمع الأول على عبد بمعنى مملوك، وغلب الجمع الثاني على عبد بمعنى آدمي، وهو تخصيص حسن من الاستعمال العربي. ومن الأول قول الله عز وجل:﴿ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ (آل عمران: 182). ومن الثاني قوله تعالى:﴿ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ (البقرة: 207)، وقوله:﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ﴾(الكهف: 65).
ثم قال عز وجل:﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾، فبين سبحانه وجه التحَسِّر عليهم، وسبب ندامتهم ؛ لأن قوله:﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾، وإن كان قد وقع بعد ذكر أهل القرية، فإنه لما عُمِّم على جميع العباد، حدث إيهام في وجه العموم، فوقع بيانه بأن جميع العباد مساوون لمن ضُرِبَ بهم المثل، ومن ضُرِب لهم في تلك الحالة الممثل بها، ولم تنفعهم المواعظ والنذر البالغة إليهم من الرسول المرسل إلى كل أمة منهم، ومن مشاهدة القرون الذين كذبوا الرسل فهلكوا، فعُلم وجه الحسرة عليهم إجمالاً من هذه الآية، ثم تفصيلاً من قول الله تعالى بعد:﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾(يس: 31).
والاستثناء في قوله: ﴿ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ مفرغ من أحوال عامة من الضمير في:﴿ مَا يَأْتِيهِمْ ﴾. أي: ما يأتيهم رسول في حال من أحوالهم إلا في حال استهزائهم به. وتقديم ﴿ بِهِ ﴾ على ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ؛ للاهتمام بالرسول المشعر باستفظاع الاستهزاء به، مع تأتِّي الفاصلة بهذا التقديم، فحصل منه غرضان من المعاني، ومن البديع.
هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل للمشركين الذين واجهوا دعوة الإسلام في بدايتها بالتكذيب، ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين الذين انتهى أمرهم فجأة بصيحة واحدة أخمدت أنفاسهم، وجعلتهم نسيًا منسيًّا. ويبدأ الحديث بعدها بالتعميم في موقف المكذبين بكل ملة ودين، ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون، وينادي على العباد نداء الحسرة وهم لا يتعظون بمصارع الهالكين الذين يذهبون أمامهم، ولا يرجعون إلا يوم الدين.