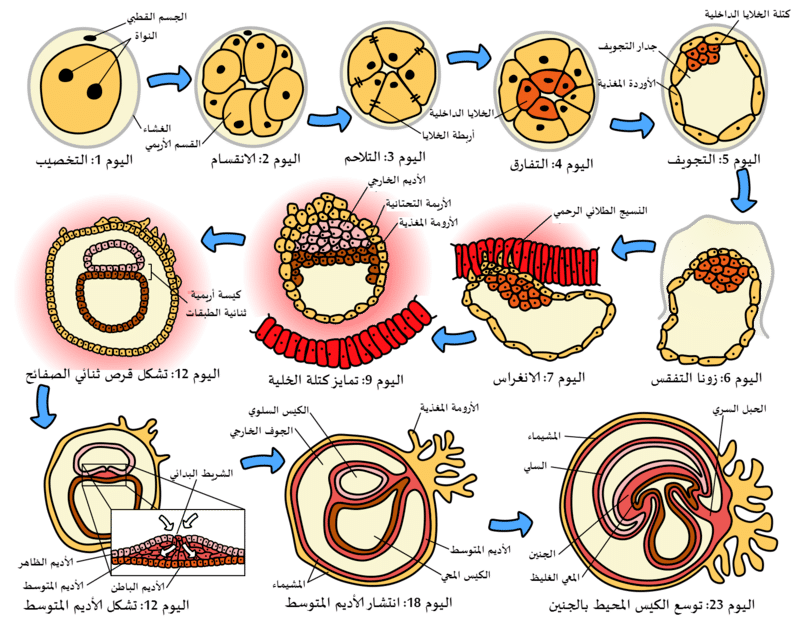تطور دراسة الإعجاز القرآني على مر العصور
الخميس/ديسمبر/2019
أ.د / عبد الغني محمد بركة
أستاذ متفرغ بكلية اللغة العربية، ووكيل الكلية الأسبق في جامعة الأزهر
بدايةً … إن استيعاب هذه الجهود العلمية الزاخرة بالأفكار والقضايا والمناقشات والآراء، في إطار مقالة مختصرة أمر فوق الطاقة.
لهذا: أرجو أن تعتبر هذه المقالة رؤوس موضوعات، تلقى عليها بعض الأضواء لتكون مرشداً لمن يرغب في مواصلة بحث الموضوع باستيعاب وتعمق، ويمكننا أن نشير على النقاط الأساسية التي سنحاول أن نجمع فيها أطراف الموضوع.
بحيث تمهد كل نقطة لما تتلوها، وتلتحم بها، ليشكل المجموع بناء مترابط الأجزاء، يعطي فهماً للموضوع حسب الطاقة.
سنبدأ ـ إن شاء الله ـ ببيان معنى الإعجاز والمعجزة، وكيف أنها ضرورة لإثبات صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم ننتقل إلى الحديث عما امتازت به المعجزة القرآنية عن غيرها من معجزات الأنبياء السابقين، نظراً للخصائص التي انفردت بها الرسالة الإسلامية، ثم نستعرض المراحل التي مرت بها قضية الإعجاز بدءاً من صدر الإسلام، وانتقالاً إلى مرحلة تالية ركز العلماء فيها جهودهم على مواجهة ما أثاره المشككون من شبهات حول الموضوع، ثم إلى مرحلة نضج القضية، وإبراز الجوانب الموضوعية التي جعلت من النص القرآني نصاً معجزاً، ثم ننتقل أخيراً إلى العصر الحديث، وما قام به علماؤه من إضافات أكدت أن الإعجاز القرآني إعجاز دائم متجدد على مدى الزمن، لتظل الدعوة الإسلامية محروسة بدليل صدقها حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
أما عن المعجزة: فهي مشتقة من الفعل: ( أعجز ).
نقول: أعجزني هذا الشيء، أي: صيرني عاجزاً، بمعنى: أنه فاق قدرتي، ولم أستطع القيام به.
ومن هنا عرف العلماء المعجزة بأنها: أمر يجريه الله على يد نبي من أنبيائه عليهم السلام، يفوق قدرة البشر، ويتحدى به النبي قومه فلا يستطيعون مجتمعين أو متفرقين أن يأتوا بشيء يماثله، والحكمة في ذلك: أن ادعاء النبوة وما يلزمه من الاتصال بالملأ الأعلى، وتلقى خبر السماء، لا تسلم به العقول دون دليل حاسم يثبته، ولهذا جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي أمراً معجزاً يكون دليلاً على صدق دعواه، حتى يتبين الحق من الباطل، وتنقطع حجة المعارضين.
ووجه دلالة المعجزة على صدق النبي، أن العقل يدرك أن الكون يسير على سنن مطردة، وأن هناك ارتباط لا يتخلف بين الأسباب ومسبباتها العادية، فالنار تحرق، والولد يولد من أب وأم، إلى غير ذلك من الربط بين الأسباب ومسبباتها، فإذا تخلفت الأسباب عن مسبباتها، فولد ولد من غير أب كعيسى عليه السلام، أو أصبحت النار لا تحرق، بل تكون برداً وسلاماً، كما حدث لإبراهيم عليه السلام، أو تحرك الجامد كما حدث لعصى موسى، إذ انقلبت حية تلقف ما يأفكون…. إذا حدث هذا حكم العقل بأن الذي فعل ذلك لا بد أن يكون فوق الأسباب ومسبباتها، وأنه يفعل ما يشاء ويختار، وأن الذي خرق العادات لا بد أن يكون هو خالقها وموجدها، وأن خرق العادات لا بد أن يكون مقصوداً، فإذا علمت الغاية، وبينت المقاصد تبين صدق ما يدعيه النبي.
ولكي تكون المعجزة قاطعة لكل حجة، كانت دائماً من جنس ما يحسنه قوم النبي وينبغون فيه، إذ تكون بهذا أقوى دلالة على صدق النبي في دعواه.
وعلى هذه القاعدة المطردة، جاءت معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً يتلى، لأن البيان كان مناط فخر العربي، وموئل تطاولهم واعتزازهم.
غير أن النظرة الدقيقة تعطي معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أبعاداً أخرى، تتناسب مع طبيعة رسالته الخاتمة.
ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين، كانت مادية ملموسة ينتهي أثرها بمجرد إعلان تعاليمها، ولا تلزم إلا من اطلع عليها أو صدق من أخبره بها، لأن ذلك هو المناسب لطبيعة هذه الرسالات السابقة على الرسالة الإسلامية.
فقد كانت كل رسالة خاصة بقوم النبي الذين بعث إليهم كما أنها رسالات مؤقتة بزمن معين، لا يمضي وقت حتى يصطفي الله نبياً جديداً، يحدد ما أندرس من الشريعة السابقة، أو يضيف إليها ويوسع في آفاقها، حسبما يقتضيه تطور البشرية.
أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلها طبيعة أخرى، إذ هي خاتمة الرسالات جميعاً، وهي الحلقة الأخيرة في سلسلة النبوات الطاهرة، كما أنها عامة للبشر جميعاً، وصدق الله العظيم حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وحيث يقول سبحانه: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)[سورة الأحزاب:40].
ومن هنا كان لا بد أن تكون معجزته شيئاً باقياً ثابتاً أبد الدهر، لتكون حجة الله القائمة على خلقه في كل زمان ومكان.
ولتظل الدعوة محروسة بمعجزتها، مقرونة بدليل صدقها إلى قيام الساعة، فكانت المعجزة المحمدية قرآناً يتلى، ويتعهد الله بحفظه وصيانته من أن يبدل أو يحرف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .
ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فيما يروى عنه أنه قال: ( ما من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) متفق عليه.
والعجيب: أن العرب ظلوا يطالبون الرسول عليه السلام بمعجزات مادية، من جنس معجزات الأنبياء السابقين، ويحكي القرآن الكريم عنهم ذلك: ) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلا بَشَراً رَسُولاً (93) )[سورة الإسراء].
ولكن الله تعالى بين لهم أنهم إذا كانوا صادقين حقاً، وفي أنهم سيستجيبون للمعجزات، فإن القرآن أكبرها جميعاً وأعلى شأناً مما يطلبون ) وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الآيات عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51))[سورة العنكبوت].
هذا، وقضية الإعجاز القرآني من أولى القضايا التي اتجه العلماء إلى دراستها، وبذلوا جهوداً هائلة في تحقيقها، والكشف عن أدلتها، وتتبع أوجهها، إذ هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الإيماني للمسلم، فالذي يطمئن عقله وقلبه، ويصل إلى اليقين بأن القرآن الكريم معجز للبشر وأنه من المستحيل أن يتمكن البشر مجتمعين أو متفرقين أن يأتوا بمثله.
أقول: إن الإنسان الذي يصل يقينه إلى هذا الحد، ليس أمامه إلا أن يسلم بأن القرآن الكريم من عند الله وما دام القرآن من عند الله فكل ما تضمنه حق خالص، لا سبيل لباطل إليه، ويكون ذلك موجباً للإيمان بما فيه، والانقياد لتعاليمه، والسير على هداه.
ولنبدأ بالقضية في مراحلها الأولى، منذ بدء الدعوة، فلا خلاف في أن للعرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم قدم راسخة في البيان والبلاغة، وقدرة فائقة في تذوق الكلام والتمييز بين جيده ورديئه، فقد امتازوا من بين معاصريهم من الأمم بالنزوع إلى الكلام الطيب، وأقاموا الأسواق الأدبية، يعرض فيها كل بليغ ما تجود به قريحته من شعر أو خطبة أو حكمة، كانوا يتبارون في التجويد، ويحتكمون إلى نقاد شهدوا لهم بالقدرة على النقد والتمييز بين الكلام، فيقدم هذا ويؤخر ذلك تبعاً لما تضمنه كلام كل منهم من بلاغة وقوة.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أنه قد حدثت قبل البعثة المحمدية أحداث كانت توطئة وتمهيداً لما سيحدث بعد البعثة من تحد للعرب جميعاً ببلاغة القرآن وإعجازه، فوجود الكعبة المشرفة في مكة وتوافد العرب من أنحاء الجزيرة العربية عليها في مواسم الحج، ووقوعها أيضاً في منتصف الطريق بين اليمن جنوباً والشام شمالاً، وهي طريق ممهدة مسلوكة لقوافل التجارة، هذا الوضع الفريد أحدث تقارباً بين اللهجات العربية، وجعل لهجة قريش هي السائدة بين العرب، ففي مكة تختلط القبائل وتتلاقح اللهجات العربية وتتقارب، وتصفي مما بها من وعورة وغرابة، فتتماذج لتصبح لهجة سائدة يتكلمها الجميع، ويبدعون بها آثارهم الأدبية، وقد أدى ذلك كله إلى أن يصبح العرب جميعاً في ربوع الجزيرة العربية، وأنحائها مؤهلين لتذوق بلاغة الكلام في راقي مدارجه.
وفي هؤلاء القوم الذين يعتزون بالبيان، ويتناقلون شوارده ودرره، وتهنأ القبيلة بالشاعر ينبغ بين أبنائها، لأنه سيكون الصوت المدافع عنها، والمذيع لمفاخرها.
في هؤلاء القوم نزول القرآن الكريم، وتلا عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتلقاه من ربه، وتتابعت نجوم القرآن الكريم على قلب رسول الله، وعلى الفور أدرك العرب أنهم أمام شيء لا عهد لهم به، وأن ما يسمعونه إنما هو كلام معجز لا يستطيعه بشر.
وقد أتضح هذا بجلاء فيما رواه التاريخ الصحيح عنهم، سواء في ذلك ما صدر عن بعضهم من أقوال، أو ما ثبت من أحوال حين تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله.
أما عن أقوالهم فمن ذلك: حديث الوليد بن المغيرة حين أتى قريشاً فقال: إن الناس يجتمعون غداً بالموسم، وقد فشا أمر هذا الرجل ـ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم ـ فهم سائلوكم عنه فبماذا تردون عليهم، فأخذوا يتدارسون الأمر فقالوا: نقول: مجنون يحنق ـ أي: يشتد غضبه فلا يدري ما يقول. فقال الوليد: يأتونه فيكلمونه، فيجدونه صحيحاً فصيحاً عادلاً، فيكذبوكم. فقالوا: نقول هو شاعر: قال الوليد: هم العرب، وقد رووا الشعر، وفهم الشعراء، وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم. قالوا: نقول كاهن، قال: إنهم لقوا الكهان، فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهنة، فيكذبونكم. ثم انصرف إلى منزله. فقالوا: صبأ الوليد ـ يعنون أسلم ـ ولئن صبأ لا يبقى أحد إلا صبأ. ثم بعثوا إليه ابن أخيه أبا جهل بن هشام ابن المغيرة، ليساومه حتى يرجع عما يراه في محمد، فعاد إلى قريش فقال: تزعمون أني صبأت، ولعمري: ما صبأت، إنكم قلتم: محمد مجنون، وقد ولد بين أظهركم، لم يغب عنكم ليلة ولا يوماً، فهل رأيتموه يحنق قط، فكيف يكون مجنوناً ولا يحنق قط؟ وقلتم: شاعر، أنتم شعراء، فما منكم أحد يقول ما يقول، وقلتم كاهن، فهل حدثكم محمد في شيء يكون في غد إلا أن يقول إن شاء الله قالوا فكيف نقول يا أبا المغيرة؟ قال: أقول: ساحر يفرق بين الرجل وامرأته، والرجل وأخيه، فنزل فيه قوله تعالى: (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) ) [سورة المدثر]، والقصة غنية عن أي تعليق فهي تفصح بكل جلاء عن حيرة صناديد قريش وقادتها ورجال الرأي فيها، في قرآن محمد، الذي لا عهد لهم بمثله.
ومما وعاه التاريخ أيضاً، أن الوليد عقبة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)[سورة النحل] فقال له: أعد، فأعاد. فقال الوليد ـ والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر.
ومن أحوالهم الدالة على تأثير القرآن فيهم، أنه ربما وصلت آيات منه إلى مسمع أشدهم عداوة للإسلام.
فإذا به يتحول إلى إنسان جديد، ويلقى وراء ظهره كل ما كان يكنه من عداوة وبغض للإسلام ونبيه، ويتقدم مبايعاً موقناً أن هذه الكلمات ليست من قول بشر. حدت هذا لعمر بن الخطاب إذ خرج ذات مساء متوشحاً سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطاً من أصحابه في بيت عند الصفا، سمع أنهم مجتمعون فيه.
فقابله أحد أصحابه وعرف مقصده فقال له: غرتك نفسك يا عمر، أفلا رجعت إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم، فسأله عمر وقد رابه ما سمع: أي أهل بيتي تعني، فأخبره أن صهره (وابن عمه) سعيد بن زيد قد أسلم، وكذلك أسلمت زوجته أخت عمر فاطمة بنت الخطاب. فذهب إليها عمر مغيظاً محنقاً.
وهنا سمع خبايا يتلو عليهما القرآن، فاقتحم الباب وبطش بصهره وبأخته فاطمة ثم أخذ الصحيفة التي لمح أخته تخفيها عند دخوله فلما قرأ صدراً منها من سورة طه قال: ما أحسن هذه الكلام وأكرمه، ثم ذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه فكبر النبي تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم، وأعز الله به الإسلام.
وعندما رأى المشركون تأثير القرآن فيمن يستمع إليه، كان طريقهم لمقاومته، هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين القرآن والناس، مهما كلفهم ذلك من تضحية، فتواصوا بعدم سماعه، وكانوا يلاقون القبائل الواردة إلى مكة في المواسم، يحذرونهم منه، ويحكي القرآن الكريم ذلك عنهم في قوله تعالى🙁 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون).
وما ذلك إلا لأنهم أدركوا تأثير هذا القرآن فيهم وفي أتباعهم، وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنهم يسحرون بين عشية وضحاها بالآيات يسمعون إليها، فتنقاد إليها النفوس، وتهوي إليها الأفئدة.
ثم جاء دور التحدي، ليحسم الأمر، ويقطع عليهم كل سبيل، فقد تحداهم القرآن الكريم، وكرر عليهم التحدي في صور متعددة فدعاهم أول مرة أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تنزل معهم إلى الأخف فالأخف فدعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلما عجزوا تنزل معهم في التحدي إلى أبعد مدى يمكن أن يصل إليه التنزيل، فاكتفى منهم بأن يأتوا بسورة واحدة منه، دون تحديد السورة، طالت أم قصرت، وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة، وهي آخر آيات التحدي، إذ نزلت في العهد المدني:(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) [سورة البقرة].
وكانت هذه الآية الكريمة قمة التحدي، بما تضمنته من إثارة واستفزاز لهم، كي يدفعوا عن أنفسهم هذه العجز، إن كانت بهم قدرة على ذلك، قد أباح لهم أن يستعينوا بمن شاءوا إن كانوا صادقين، ثم بالغ في إثارتهم واستفزازهم حتى يثبت أن قدرتهم على المعارضة منفية تماماً، فلن تقع ولن تكون فقال لهم: ولن تفعلوا أي: إن هذا فوق قدرتكم، وفوق الحيلة، وفوق الاستعانة، ثم جعلهم وقوداً، ثم قرنهم بالأحجار، ثم سماهم كافرين؛ وليس بعد ذلك مدى يذهب إليه في الإثارة والاستفزاز، فلو كان بهم طاقة لدفعوا عن أنفسهم هذا الهوان، ولعارضوا القرآن حتى يبطلوا دعواه.
إن طبيعة الأشياء تقتضي ألا يسلم الإنسان لخصمه بالفضل، وهو يجد سبيلاً إلى دفعه ولا يرضى إنسان لنفسه أن يوصم بالعجز وهو قادر على قهر أعدائه، فكيف يجوز أن يقوم من يدعي النبوة في قوم من صميم العرب، أهل اللسن والفصاحة، فيخبرهم أنه رسول الله تعالى إلى الخلق كافة، وأنه يبشر بالجنة، وينذر بالنار، ثم يسفه أحلامهم، ويسلب آلهتهم كل قيمة، ثم يقول: حجتي أن الله تعالى قد أنزل علي كتاباً عربياً مبيناً، تعرفون ألفاظه، وتفهمون معانيه، ألا إنكم لا تقدرون على أن تأتوا بمثله، ولا بعشر سور منه، ولا بسورة واحدة حتى وإن استعنتم بمن شئتم من الجن والإنس، كيف يصنع معهم ذلك، ثم لا تدعوهم أنفسهم إلى معارضته ليبينوا خطأ دعواه، ألا يكون ذلك عجزاً منهم، واعترافاً بأن ذلك فوق قدرتهم.
ولو أن العرب قد تركوه وشأنه، لقلنا إنهم قد تجاهلوه استخفافاً بأمره، ولكنهم قد بلغ بهم الغيظ من مقالته حداً تركوا معه أحلامهم الراجحة، وواجهوه بكل قبيح، ولقوه بكل أذى ومكروه ووقفوا له بكل طريق، ودارت بينهم وبينه المعارك الطاحنة، التي قتل فيها صناديدهم، ونال منهم ونالوا منه.
فهل يعقل أن يتركوا إبطال حجته، وهي لا تكلفهم أكثر من معارضة ما جاء به بكلام من مثله، ثم يلجأون إلى مواجهته بأمور تأباها الحكمة، ويدعو إليها السفه، ولا يقدم عليها إلا من أعوزته الحيلة وعز عليه المخلص، وأيقن أنه لا سبيل له إلى ما يرمي إليه.
وهكذا حسم الأمر وأصبح الإعجاز القرآني حقيقة تاريخية لا جدال حولها ولا شبهة فيها، واستمر الحال على هذا طوال القرن الأول والثاني الهجريين، حتى إذا جاء القرن الثالث الهجري وحمل معه دعاوى وشبهات أثارها الحاقدون، الذين سبقوا إلى الإسلام بحكم الغلبة، ونفوسهم تنطوي على حقد دفين، ينتهز فرصة مواتية ليتنفس عن أحقاده وبغضه، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ قضية الإعجاز القرآني.
هذه المرحلة الجديدة يمكن أن نطلق عليها ( مرحلة الدفاع عن الإعجاز القرآني )، وقد تمثل ذلك في الرد على ما أثاره المشككون من شبهات، إضافة إلى بحوث علمية دقيقة تبرز السمات الموضوعية التي بين بها الأسلوب القرآني وتصل ببلاغته إلى حد الإعجاز.
أما عن الشبهات التي أثيرت فمن أهمها شبهتان:
الشبهة الأولى:القول بأن عجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن لم يكن بسبب عدم قدرتهم على ذلك، بل إنهم عجزوا لأن الله صرفهم عنه بما أطلق عليه القول بالصرفة.
الشبهة الثانية:أن القرآن الكريم يتضمن بعض الألفاظ والأساليب المعيبة في مقامها وسياقها.
ونبدأ بمناقشة موضوع القول بالصرفة.
يرى بعض الباحثين أن فكرة الصرفة قد تسربت إلى الفكر الإسلامي من الثقافة الهندية، وأن بعض المثقفين من علماء المسلمين اطلعوا على أقوال ـ البراهمة ـ رجال الدين في الديانة الهندية في كتابهم المسمى ـ الفيدا ـ، وهو يشتمل على مجموعة من الأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم.
ويقول جمهور علمائهم: إن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها لأن ـ براهماً ـ صرفهم عن أن يأتوا بمثلها، وعندما دخلت الأفكار الهندية في عهد أبي جعفر المنصور ومن وليه من حكام بني العباس، تلقفها الذين يحبون كل وافد من الأفكار فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا ذلك القول، ويطبقوه على القرآن الكريم وإن كان لا ينطبق، فقال قائلهم: …. إن العرب إذا عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن، ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونظمه، بل كان عجزهم لأن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله.
ويقال: أن أول من جاهر بهذا القول وأعلنه ودعا إليه ودافع عنه هو إبراهيم ابن سيار الشهير بالنظام، المتوفى سنة 224.
والنظام هذا هو رأس المعتزلة وعمدة المتكلمين، وأستاذ الجاحظ.
والواقع: أن مفهوم الصرفة كما ذكره النظام لم يكتب له الرواج، نظراً لأنه يسلب النص القرآني إعجازه الذاتي، ويدعى أنه في طوق العرب لو لم يصرفهم الله عن معارضته.
وقد قال غيره من العلماء بالصرفة لكن مفهومها عندهم مغاير لمفهومها عند النظام، فقد نسب القوة بالصرفة إلى الشريف المرتضى، وهو من علماء الشيعة الذي يشار إليهم بالبنان.
ومفهوم الصرفة عند الشريف المرتضى: أن العرب قادرون على النظم والعبارات المماثلة لما جاء في القرآن الكريم، لكن عجزهم أنه كان بسبب أنهم لم يعطوا العلم الذي يستطيعون به محاكاة القرآن.
وهذا القول ينافيه أن الله سبحانه وتعالى طالبهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات… وأعفاهم من أن يكون كلامهم مشتملاً على ما في القرآن من علم، واقتصر على التحدي بالنظم والعبارة واللفظ.
على أنه من العلماء من يقول بالصرفة، باعتبارها وجهاً من وجوه الإعجاز، من جهة كونها دالة على القوة وباعتبار أن ذلك ـ على فرض حدوثه ـ يعتبر أمراً خارجاً عن العادة كسائر المعجزات التي دلت على النبوة، أي: أن ذلك احتمال عقلي، والتسليم به إنما هو على سبيل التنزل مع الخصم والمجادلة والمنافحة عن الحق، وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيعه بشر، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق.
باعتبار أنها لو صحت فإنها لا تطعن في أن القرآن الكريم من عند الله، بل تثبت أن الصرفة دليل على النبوة، وهذا لا يمنع من أن القرآن في نفسه معجز.
وأياً كان الأمر في مفهوم الصرفة عند أصحاب القول بها، فقد تصدى العلماء لهذه الشبهة، واقتلعوها من جذورها، وبلغوا من ذلك مبلغاً لا مزيد عليه.
وسوف أوجز أقوال العلماء في الرد على أصحاب هذه الشبهة وإبطالها دون الرد على أصحاب هذه الردود، تجنباً للتكرار.
وإن كان أهم هؤلاء العلماء: الخطابي ( ت سنة 388 ) في كتابه: بيان إعجاز القرآن، والرماني ( ت سنة 386 ) في كتابه: النكت في القرآن. والباقلاني ( ت سنة 403 ) في كتابه: إعجاز القرآن… وعبد القاهر الجرجاني ( ت سنة 471 ) في كتابه: الرسالة الشافية في إعجاز القرآن.
استدل العلماء على بطلان القول بالصرفة بأدلة/ منها:
أولاً:لو كان الأمر على ما ذهبوا إليه، وكان الإعجاز بالصرفة حقاً، فإنه يلزم من ذلك أن يكون العرب قد تراجعت حالها في البلاغة والبيان، وفي جودة النظم وشرف المعنى، وأن يكونوا قد نقصوا في قرائحهم وأذهانهم، وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون، وأن تكون أشعارهم وخطبهم التي قاموا بها بعد أن سمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدوا إلى المعارضة قاصرة عما سمع منهم من قبل القصور الشديد.
وإذا كان الأمر كذلك، وأنهم منعوا منزلة من الفصاحة كانوا عليها، لزمهم أن يعرفوا ذلك من أنفسهم، ولو عرفوه لجاء عنهم ذكره، ولكانوا قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جئتنا به، ولكنك سحرتنا، واحتلت علينا في شيء حال بيننا وبينه، وكان أقل ما يجب عليهم في ذلك: أن يتذاكروه فيما بينهم، ويشكو البعض إلى بعض، وإذا كان ذلك لك لم يرد، ولم يذكر أن كان منهم قول في هذا المعنى لا ما قال ولا ما كثر، فهذا دليل على أنه قول فاسد، ورأي ليس من آراء ذوي التحصيل. فإن قالوا: إنه نقصان حدث في فصاحتهم من غير أن يشعروا به، قيل لهم: إذا كانوا لم يشعروا بما حدث لهم من نقص ما فلا يتصور أن تقوم لهم حجة بالعجز عنه مثل القرآن.
ثانياً:لو سلمنا أن العرب المعاصرين للبعثة قد صرفوا كما يزعمون، لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل القرآن في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم.
فلما لم يوجد في كلام من قبلهم مثله، علم أن ما دعاه القائل بالصرفة ظاهره البطلان.
ثالثاً: إن في سياق آية التحدي ما يدل على فساد هذا القول، وذلك أنه لا يقال عن الشيء يمنعه الإنسان بعد أن كان قادراً عليه ـ لا يقال في هذه الحالة: إني قد جئتكم بما لا تقدرون على مثله ولو احتشدتهم له، وإنما يقال: إني أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم تستطيعونه وأمنعكم إياه وما شاكل ذلك. كما يقال مثلاً للأشداء، إن الآية أن تعجزوا عن رفع ما كان يسهل عليكم رفعه، فقد بان إذن ـ أنه لا مساغ لحمل الآية على ما ذهبوا إليه.
رابعاً: الأخبار التي جاءت عن العرب في شأن تعظيم القرآن، وفي وصفه به، من نحو أن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة…. الخ.
فمحال أن يعظموه وأن يبهتوا عند سماعه، وهم يرون فيما قاله الأولون ما يوازيه.
وهكذا ساق العلماء الدليل تلو الدليل على بطلان القول بالصرفة، وتأكيد أن بلاغة القرآن تعود إلى أمر ذاتي فيه، جعله معجزاً للبشر.
هذا عن شبهة القول بالصرفة، أما عن شبهة أن القرآن الكريم قد تضمن ألفاظاً وأساليب ليست مما تقتضيه البلاغة، فقد فند العلماء أيضاً هذه الشبهة بردود مفحمة، من ذلك مثلاً ما ذكره الخطابي في رده على بعض ما أثاروه من شبهات.
فقد قال المشككون في قوله تعالى: (قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) [سورة يوسف].
قالوا: إنما يستعمل في فعل السباع خصوصاً ( الافتراس ) يقال: افترسه السبع، هذا هو المختار الفصيح في منعاه، فأما ( فأكله ) فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان.
ويرد الخطابي قائلاً. فإما قوله تعالى فأكله الذئب فإن الافتراس معناه في فعل السبع والقتل. فحسب، وأصل الفرس ـ دق العنق، والقوم إنما ادعوا على الذئب أنه أكله أكلاً، وأتى على جميع أجزائه. وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم لهم بأثر باق منه، يشهد بصحة ما قالوه، فادعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفرس لا يعطي تمام هذا المعنى. وبهذا يكون اللفظ القرآني قد وقع مطابقاً للمعنى المراد.
وإليكم نموذجاً آخر.
قال تعالى: (وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم )[سورة ص] قال المشككون: المشي ـ في هذا ليس بأبلغ الكلام، ولو قيل بدل ذلك: امضوا وانطلقوا ـ لكان أبلغ وأحسن.
ويرد الخطابي:أن المشي ـ في هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى، وذلك لأنه إنما قصد الاستمرار على العادة الجارية، في غير انزعاج منهم، ولا انتقال عن الأمر الأول، وذلك أشبه بالثبات والصبر على الأمر المأمور به في قوله واصبروا والمعنى: كأنهم قالوا: امشوا على هيأتكم، ولا تبالوا بقوله.
ولو قيل: امضوا وانطلقوا… لكان فيه زيادة انزعاج ليس في قوله ( امشوا ) والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه.
فالخطابي هنا يربط بين المقام واختيار اللفظ الملائم له دون غيره، فلما كان الملأ من قريش يريدون أن يشعروا أتباعهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحق الاهتمام به، ولا الاكتراث له، لأنه ظاهر البطلان في زعمهم، فالواجب تجاهله تمام، كأن شيئاً لم يحدث، وأن أفضل ما نواجهه به نمضي في حياتنا، ونتناسى الأمر كله، وهذا المقام استدعى التعبير ـ امشوا ـ لأنه هو الملائم لما يريدون أيهما إتباعهم به.
أما امضوا وانطلقوا ـ فلا تناسب المقام كما توحي به من الانزعاج وتغيير العادة الرتيبة التي اعتادوها، والأمر ليس كذلك ـ في زعمهم ـ بالنسبة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أقل من أن يأبهوا له.
وذلك منهم في تضليل أتباعهم وطمس معالم الحقيقة عنهم.
وهكذا يمضي الخطابي وغيره من علماء تلك الفترة يوردون الشبهات ويفندونها بما كشف عن وجده الحق في البلاغة القرآنية.
ننتقل الآن إلى ما أنجزه علماء هذه المرحلة، من بحوث علمية دقيقة، تبرز السمات الموضوعية التي اتسم بها الأسلوب القرآني، وتصل ببلاغته إلى حد الإعجاز.
نبدأ أولاً:بما أبرزه علماء هذه المرحلة، من تعدد وجه الإعجاز القرآني، وأنهم قسموا وجوه الإعجاز قسمين، الأول الوجه المعجز الذي وقع به التحدي، وهو الإعجاز البلاغي وحده، لأنه الوجه المطرد في كل سورة من سور القرآن الكريم، وقد كان التحدي بأن يأتوا بسورة من سوره، والوجه الذي يعتبر القاسم المشترك في كل السور إنما هو الإعجاز البلاغي.
القسم الثاني:وجود معجزة في ذاتها لكن لم يقع بها التحدي، كالإخبار بالغيب، وما تضمنه القرآن من علوم ومعارف لا يتهيأ لبشر الإحاطة بها… إلى غير ذلك من الوجوه المعجزة للبشر التي سنتعرض لبعضها.
وبهذا كان القرآن الكريم معجزاً للعالم كله، فطبيعة الرسالة الإسلامية هي التي تستوجب هذا التعدد في الجوانب المعجزة بالقرآن الكريم، فهي ـ كما سبق أن أوضحنا ـ خاتمة الرسالات، كما أنها موجهة إلى الجنس البشري كله، وهذه الخصائص التي انفردت بها دون سائر الرسالات اقتضت أن تكون معجزتها أمراً معجزاً في هذا الإطار الممتد عبر الزمن إلى يوم الدين، وعبر العالم كله بما يضم من أجناس وشعوب وثقافات ومذاهب.
ومن هنا قسم العلماء البشر في إدراك الإعجاز القرآني في ثلاثة أقسام:
أول الأقسام:من تناهى في معرفة اللسان العربي، ووقف على طرقه ومذاهبه ـ كالعرب الذين نزل فيهم القرآن، ومن أتى بعدهم ممن راض نفسه بالعلم واكتملت لديه آلة التمييز بين الأساليب وخصائصها، وهذا القسم يدرك الإعجاز القرآني إدراكاً ضرورياً لا يحتاج معه إلى بحث أو تدقيق. ويكفيه في ذلك التأمل والتصور.
القسم الثاني:وهو المقابل للقسم الأول، ويضم هذا القسم من ليسوا من أصحاب اللسان العربي، على ثقافتهم وحضاراتهم، وهؤلاء يمكنهم إدراك الإعجاز القرآني عن طريق الاستدلال العقلي، بأن يعلموا عجز العرب ـ وهم أهل اللسان الذي نزل به أذن أشد عجزاً منهم.
كما يمكنهم إدراك الإعجاز القرآني من خلال معرفتهم بالوجوه الأخرى التي اقتضتها حكمة الله ورحمته، فغير العربي يجد في هذه الوجوه الأخرى إعجازاً يلزمه بالتصديق بأن هذا الكتاب من عند الله، وأن ما تضمنه هو شرع الله الواجب الإتباع.
وهذه الوجوه في تعددها واختلاف طبيعتها وافية تماماً بالإلزام على مدى التاريخ، ولكل الأجناس والشعوب، وستظل كذلك ـ إن شاء الله ـ ما بقيت الحياة.
والعجيب في الأمر: أن إدراك الإعجاز في الوجوه التي تضمنها القرآن الكريم التي لم يتحد بها العرب الأوائل أمر ميسور لا يتطلب سوى صدق التوجه والاستعداد لقبول الحق.
لأن هذه الوجوه تعود إلى ضوابط موضوعية ملزمة لكل عاقل، وهل يجادل أحد في أن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يستطيع كبشر أن يخترق حجب الغيب ويخبر عما كان وما سيكون منها، إذاً لا بد أنه يستمد ذلك من قوة أعلى من البشر، وهل يجادل أحد في أنه عليه السلام، لا يستطيع ـ كبشر ـ أن يأتي من العلوم الكونية والإنسانية ما لا يدرك البشر بعضه إلا بعد مرور قرون متطاولة.
وقل مثل هذا في جميع الوجوه المعجزة التي تضمنها القرآن الكريم، ولم يتحد بها العرب الأوائل.
القسم الثالث:من كان من أهل اللسان العربي، إلا أنه لم يبلغ في الفصاحة الحد الذي يتناهى إلى معرفة وجوه تصرف اللغة، وطرق الأساليب. وهؤلاء عليهم أن يأخذوا أنفسهم بدراسة الأساليب وحدود البلاغة ـ ومواقع البيان، إلى غير ذلك مما يؤهلهم لإدراك ما في القرآن الكريم من بلاغة معجزة، وإلا فليكتفوا بالاستدلال العقلي وبالوجوه الأخرى الدالة على الإعجاز، كما هو الشأن فيمن ليسوا من أهل العربية.
ننتقل الآن إلى جهود علماء هذه المرحلة الزمنية في إبراز السمات الموضوعية للأسلوب القرآني التي وصلت به إلى درجة الإعجاز، ونكتفي هنا بما جاء في كتاب ( إعجاز القرآن ) للباقلاني، فقد تضمن كل ما نقله عمن سبقه وأضافه هو إليه ما هداه إليه اجتهاده في الموضوع.
يرى الباقلاني أن السمات المميزة للأسلوب القرآني وانفرد بها متعددة منها:
أولاً: مغايرة الأسلوب القرآني لجميع أنماط التعبير المعروفة عند العرب فالقرآن الكريم ليس شعراً أو سجعاً ولا مرسلاً إرسالاً، كما هو الشأن في صور التعبير عند العرب، لكنه نمط فريد، لا يشبه شيئاً من أنماط تعبيرهم عن المعاني.
وقد بذل الباقلاني جهداً مضنياً في إثبات فكرته هذه، وقد أصاب في بعض ما قال، ولم يسلم له بعضه مما لا يتسع المقام لتفصيله.
ثانياً: عدم التفاوت الفني في الأسلوب القرآني، ويعني بذلك: أن القرآن الكريم في جميع سوره وآياته على درجة واحدة من البلاغى، ولا يتدنى عن شيء، وتلك سمة لا طاقة للبشر بها، ويتضح ذلك في جوانب كثيرة، فالقرآن الكريم لا يتفاوت على كثرة ما يتصرف فيه من الأعراض من قصص ومواعظ، واحتجاج وحكم وأحكام، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، إلى آخر الأغراض التي تضمنها القرآن الكريم.
والباقلاني: محق في كل ما قاله عن هذه السمة التي انفرد بها القرآن دون غيره، فهذا شيء لا يمكن أن يتحقق لبشر مهما سمت منزلته، وتعاظم اقتداره البياني، وأمامنا آراء النقاد تؤكد ذلك، وتجمع عليه إجماعاً لا يشذ عنه أحد.
لقد كان العرب عندما يوازنون بين الشعراء، يضربون المثل في الإجادة، بامرىء القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهيراً إذا رغب، ومعنى ذلك: أن كلاً من هؤلاء يجود في غرض معين ويشهد له بالتفوق فيه، ومؤدى ذلك: أنه يقصر في غير هذا الغرض.
وعندما حاول صاحب كتاب ( الواسطة بين المتنبي وخصومه )… الدفاع عن المتنبي، كان أقصى ما يريد في دفاعه عنه قوله: ليس بغيتنا فيما قصدنا، الشهادة لأبي الطيب بالعصمة، وإنما غايتنا أن نلحقه بأهل طبقته، وأن نجعله رجلاً من فحول الشعراء، ونمنعك من إحباط حسناته بسيئاته، ولا نسوغ ذلك التحامل على تقدمه في الأكثر بتقصيره في الأقل… وهذا اعتراف من أكبر المدافعين عن المتنبي بما في شعره من تفاوت بين الإجادة والتقصير. وتلك غاية ما يستطيعه المدافع عنه.
ولقد قام الباقلاني بعمل رائع حقاً ـ عندما عمد إلى قصيدتين من عيون الشعر العربي بالنقد، إحداهما: معلقة امرىء القيس، حامل لواء شعراء الجاهلية، والأخرى للبحتري، من أحب الحظوة والتقدم عند نقاد الكلام، والقيمة الحقيقة لما قام به الباقلاني، أنه أبرز هذه الحقيقة وأكدها.
وهي: أن البشر لا يمكن أن يصل بأدبه على الكمال، بل لا بد أن يعتريه التفاوت، ويعلو ويهبط، ويحلق ويهوي.
أما القرآن الكريم فأينما يممت لم تقع عينك منه إلا على الطريقة المثلى للتعبير، والمطابقة الكاملة لما يقتضيه الحال.
وسوف أورد ـ إن شاء الله ـ شواهد قرآنية في أغراض متفاوتة تؤكد هذا كله. عندما أجد السياق المناسب لذلك.
ثالثاً:تميز الكلمة من القرآن غيرها من سائر الكلام، بالرونق والفصاحة، ويتبين ذلك في القرآن ورجحان فصاحته، بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف الكلام، أو تقذف ما بين شعر، فتأخذ الأسماع، وتتشوق إليها النفوس، ويرى وجه رونقها بادياً، غامراً سائر ما تقرن به كالدرة التي ترى في سلك الخرز، وكالياقوتة وسط العقد.
رابعاً: إن اله تعالى قد سهل سبيل القرآن بجملته، فهو خارج عن الوحشي المستكره، والغريب المستنكر وعن الصنعة المتكلفة، وجعله سبحانه قريباً إلى الأفهام، ويبادر لفظه معناه إلى القلب، يساير المغزى منه عبارته إلى النفس، وهو مع ذلك ممتنع المطلب، غير نطمع مع قربه في نفسه، والموهبة مع دنوه أن يقدر عليه أو يظفر به.
وهكذا مضى الباقلاني وغيره يعددون السمات التي انفرد بها الأسلوب القرآني وبوأه منزله الإعجاز.
ولننتقل على مرحلة جديدة يمكن أن نطلق عليها… ( مرحلة نضج قضية الإعجاز البلاغي ). ويأتي على قمة الدارسين لقضية الإعجاز القرآني في هذه المرحلة، الإمام عبد القاهر الجرجاني ( المتوفى سنة 471 هـ )، فقد كانت دراساته البلاغية في مجملها، تنطلق من إحساس عميق، بأن قضية الإعجاز القرآني يجب أن تحتل المقام الأول في اهتمامات العلماء، وأن إدراك الإعجاز القرآني لا يتم إلا بدراسة متأنية واعية لخصائص التعبير، التي تجعل بعضه يعلو بعضاً، حتى يصل إلى درجة تنقطع عندها الآمال في معارضته، وهي درجة (الإعجاز ).
وآراء عبد القاهر حول الموضوع، موزعة في كتبه البلاغية، وأهمها: دلائل الإعجاز، والرسالة الشافية، وأسرار البلاغية.
ويمكننا أن نختصر آراءه حول القضية في ثلاثة موضوعات أساسية تدور حولها دراساته في كتبه كلها.
أولها: أن القرآن معجز ببلاغته.
وثانيها: أن بلاغة القرآن في نظمه، فإعجازه في نظمه.
وثالثها: بيان طبيعة النظم وما هيته.
وسنحاول ـ إن شاء الله ـ أن نتتبع هذه الموضوعات الموزعة في كتبه، ونبرز جوانبها المتعددة، بما يجعلها صورة دقيقة لآرائه في القضية.
أولاً: القرآن الكريم معجز ببلاغته:
يمهد عبد القاهر لإثبات ذلك بذكر بعض الحقائق التي يؤدي التسليم بها إلى التسليم بأن القرآن الكريم معجز ببلاغته فيقول:
( معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، ومنازل يعلو بعضها بعضاً، وأن علم ذلك علم يخص أهله، وأن الأصل والقدوة فيه للعرب، ومن عداهم تبع لهم، وقاصر عنهم فيه.
وأنه لا يجوز أن يدعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه الوحي، وكان فيه التحدي، أنهم زادوا على أولئك الأولين، أو كملوا في علم البلاغة أو تعاطيه ما لم يكملوا له… والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى، أو ينكره جاهل أو معاند.
وإذا نظرنا في دلائل أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، وفي أقوالهم حين تلي عليهم، وتحدوا بأن يأتوا بمثله، وجدنا أحوالهم وأقوالهم تفصح بأنهم لم يشكوا في عجزهم عن معارضته، والإتيان بمثله، ولم تحدثهم أنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبيلاً على وجه من الوجوه.
ثم يورد عبد القاهر بعد ذلك من أقوال العرب الذين نزل فيهم القرآن وأحوالهم ما يؤكد هذه الحقيقة.
على نحو ما سبق به من أقوال العلماء، التي أشرنا إليها قبل ذلك.
وبعد أن يصل إلى هدفه من إثبات ذلك بأقوالهم أنفسهم، وبمناقشة من أتى بعدهم، وإبطال دعواهم المشككة في بلاغة القرآن من ادعاء ( الصرافة ) وغيرها، ينتقل إلى النقطة التالية وهي:
ـ إن بلاغة القرآن في نظمه، فإعجازه في نظمه. وهنا يذكرنا عبد القاهر، بأن المزية التي يعود إليها تقدم كلام على كلام في البلاغة، إنما تدرك بالفكر.
ويتوصل إليها بإعمال النظر وبذل الجهد.
فهل يمكن أن يكون في الكلمات المفردة ما يدرك ويستنبط بالرؤية والجهد، إن الكلمات إرض مشاع، لكل قائل أن يأخذ منها ما يحقق غرضه.
وكذلك لا يجوز أن يكون الإعراب من الوجه التي تظهر بها المزية، وذلك لأن العلم بالإعراب مشترك بين العرب جميعاً، فليس أحدهم أعلم من غيره بأن إعراب الفاعل الرفع، أو المفعول النصب.
ومن العجيب: أننا إذا نظرنا في الإعراب، وجدنا وجه التفاضل فيه محالاً، لأنه لا يتصور أن يكون للرفع والنصب في كلام مزية عليهما في كلام آخر، وإنما الذي يتصور، أن يكون معنا كلاماً قد وقع في إعرابهما خلل، ثم كان أحدهما أكثر صواباً من الآخر، وكلاماً قد استمر أحدهما على الصواب ولم يستمر الآخر، ولا يكون هذا تفاضلاً في الإعراب، ولكن تركا له في شيء واستعمالاً له في آخر.
وكذلك لا تعود الفضيلة في الكلام بأن يكون المتكلم قد استعمل من اللغتين في الشيء أصحهما وما يقال أنها أفصحهما، ولا بأن يكون قد استعمل الغريب من الألفاظ، لأنه العلم بجميع ذلك لا يعدو أن يكون علماً باللغة، وبأنس الكلم المفردة، وبما طريقة الحفظ، دون أن يستعان عليه بالنظر وإعمال الفكر.
وإذا كانت المزية التي توجب تقدم الكلام على غيره، لا تعود إلى شيء مما ذكر، فلا شك أنها تقود إلى النظم وصياغة العبارة، فذلك هو الجانب الوحيد الذي يحتاج إلى الفكر وبذل الجهد ثم أننا نعلم أن تفضيل الكلام على غيره، ووصفه بالفصاحة والبلاغة، إنما يعود لأمر أحدثه في الكلام، وشيء كان له جهد فيه، وإذا كان كذلك فينبغي أن ننظر إلى المتكلم، هل يستطيع أن يزيد من عند نفسه شيئاً في اللفظ ليس في اللغة، حتى يجعل من صنيعه مزية يعبر عنها بالفصاحة.
إذا نظرنا وجدنا أنه لا يستطيع أن يصنع باللفظ شيئاً أصلاً، ولا أن يحدث فيه وصفاً، كيف وإنه أفسد على نفسه وأبطل أن يكون متكلماً، لأنه لا يكون متكلماً حتى يعمل أوضاع اللغة على ما وضعت عليه فلم يبق للمتكلم شيء ينسب إليه سوى طريقة نظم العبارة، أو صياغة الفكرة في ألفاظ، عن طريق تعليق الكلمات ببعضها البعض، وفق معاني النحو، لتصبح صورة للمعنى في نفسه. وهذا يجيء الدور على بيان مفهوم النظم وماهيته.
وجوهر النظم عند عبد القاهر، أن تصاغ العبارة بطريقة تفصح تماماً عما في نفس قائلها، وتكشف عما يريد أن يوصله إلى مخاطبة، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت عبارته صورة للمعنى القائم في نفسه فالمتكلم في صياغته للعبارة، إنما يقتفي أثر المعنى في نفسه، ويرتب عبارته حسب ترتيب المعنى، فالبليغ صانع، له من صناعته بمقدار ما بذل من جهد في سبيل صناعة أسلوب جميع، وعليه أن يختار أسلوب العرض المناسب، الذي يتضمن من الخواص ما يكون مطابقاً للمعنى القائم في نفسه، بدءاً من اختيار الألفاظ التي هي ألصق بالمعنى من حيث معناها اللغوي، ودلالاتها المتعددة بجرسها وإيحاءاتها التي اكتسبها طوال استعمالها في أذهان مستمعيها، ومروراً باختيار الصيغة لمطابقتها بخواصها لدقائق جوانب المعنى وخرافية، وانتهاء بإبراز في الصورة المناسبة لما يقتضيه المقام، ومن هنا كان اختلاف الأدباء في عرض المعاني والتعبير عنها.
ذلك لأن المعنى الواحد تتعاقب عليه الصور، ويصوغه كل أديب في صورة فيها من السمات والخصائص ما يبرر نسبتها إليه دون سواه، وإن كان أصل المعنى أو الغرض العام واحداً في الجميع، وتتفاوت هذه الصور في الجمال بمقدار التوفيق في المآخاة بين المعنى والصورة الدالة عليه.
وشواهد ذلك حاضرة، ننظر إلى قول الناس: الطبع لا يتغير.
فتر فيه معنى عامياً غفلاً معروفاً في كل جيل، ثم ننظر إلى قول المتنبي:
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
هذا، وقد لقيت آراء عبد القاهر ما هي أهل له، من قبول العلماء الذين تلقوها، وهيأ الله منهم من تكفل بالجانب التطبيقي لها، وعلى رأسهم الإمام جار الله الزمخشري ( المتوفى سنة 538) في كتابه تفسير القرآن الذي سماه ( الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، والذي أصبح منهلاً ينهل منه الباحثون عن أسرار الإعجاز القرآني. كما هيأ له من ضبط ولمَّ شعثها وضبط قواعدها. وترتيب أبوابها وعلى رأس هؤلاء: الفخر الرازي في كتابه ( نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز ).
غير أن الرازي في محاولته لضبط آراء أستاذه غلبت عليه طبيعته المنطقية الفلسفية، فبدت واضحة في عمله. ووقع في خطأ أفسد ما حاول إصلاحه، فآراء عبد القاهر على ما بها من توزع في مواطن معالجتها، وإطناب في محاولة الإقناع بها، كانت تساق في أسلوب أدبي يخاطب الوجدان والذوق، ويبرز أسرار جمال التعبير بأسلوب رقيق شفاف يستهوي القلوب.
أما الرازي، فقد أحال الأمر إلى مجال للجدل المنطقي، وتتبع لما توجيه القسمة العقلية للآراء فتتابعت تقسيماته للموضوعات إلى عشرات الأبواب ومئات الفصول، وأمثالها من القواعد والتنبيهات التي يصل القارىء في تتبعها.
وهذا المسلك الذي اختطه الرازي ظل طوال قرون مسيطراً على عقول الباحثين، فساروا خلفه مستسلمين، يتبارون داخل دائرة مغلقة لا تجد في ثناياها غير تلخيص كتاب، ثم إعادة للتلخيص، فحاشية على الشرح، ثم تعليق على الحاشية، إلى آخر هذه السلسلة العقيمة التي لا تتضمن، على الرغم مما بها من جهد عقلي خارق، وقدرة مذهلة على الحجاج ـ لا تتضمن شيئاً مما كانت البلاغة أحوج ما تكون إليه لتؤدي دورها في صقل المواهب، وتنمية الملكات القادرة على الإحساس بجماليات التعبير وتذوق محاسنه.
وتطاول الزمن دون أن يتغير هذا المنهج في البحث، حتى أذن الله تعالى لهذه الأمة أن تفيق من غفوتها، وأن تنفض عنها الكثير من المعوقات التي تشل حركتها.
وعلى أيدي رواد النهضة فبعثت من جديد كتب عبد القاهر ورجال مدرسته، التي يتسم منهجها باستلهام النصوص الأدبية وأسرارها.
وعرض خواطر العلماء ونظراتهم في تلك النصوص بأسلوب مشرق مضيء يستهوي الدارس، ويضع يده على موطن جماله، ويفصح عن سر سموه.
وسنختار علماً من هؤلاء كنموذج لمن تعرض لقضية الإعجاز القرآني في العصر الحديث، وهو المرحوم الدكتور / محمد عبد الله دراز، وكتابه ( النبأ العظيم ).
يعتبر كتاب … النبأ العظيم… كتاباً فريداً في منهجه الذي اتبعه في دراسة هذه القضية والإقناع بها لأنه كما يقول مؤلفه: حديث يبدأ من نقطة البدءـ فلا يتطلب من قارئه انضواء تحت راية معينة، ولا اعتناقاً لمذهب معين، ولا يفترض فيه تخصصاً في ثقافة معينة، ولا حصولاً على مؤهل معين، وإنما يناشد القارىء فقط أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء، إلا من فطرة سليمة، ورغبة صادقة في الوصول إلى الحق، وسوف يأخذ المؤلف بيد القارىء مجتازاً به مراحل البحث، التي يسلم بعضها إلى بعض، في رفق وأناة يصل إلى نهاية المطاف، الذي لا يسع القارىء إلا التسليم به.
ويتضمن الكتاب بحوثاً تتضمن مرحلتين متتابعتين في البحث.
الأولى: دراسة تمهيدية خارجة عن جوهر القرآن نفسه، هدفها الوصول إلى أن القرآن الكريم إلهي المصدر، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه إلا الحفظ، ثم الحكاية والتبليغ، ثم البيان والتفسير، ثم التطبيق والتنفيذ.
المرحلة الثانية:دراسة في جوهر القرآن نفسه. هدفها إثبات الإعجاز القرآني من أي النواحي اتجهنا إليه، سواء في ذلك ناحية أسلوبه، أو ناحية علومه ومعارفه، أو ناحية اثره الذي أحدثه في العالم وغير به التاريخ.
أما عن إثبات أن القرآن الكريم إلهي المصدر، فيرى الدكتور / دراز: أنه لا خلاف على أن القرآن الكريم جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم أما من أين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أمن عند نفسه ووحي ضميره، أم من عند معلم، ومن هو هذا المعلم فهذا مات يحتاج إلى بيان.
وأول ذلك: أن القرآن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله لفظه ومعناه.
قال تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً ).
وقال سبحانه لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي .
والمعروف أن كثيراً من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها، أما أن أحداً ينسب لغيره أنفس آثار عقله، وأغلى ما تجود به قريحته، فذلك ما لم يلده الدهر.
وقد يحيك في صدر جاهل: أن هذا الزعيم قد نسب القرآن إلى الوحي الإلهي، لأنه في ذلك ما يعنيه على تحقيق غرضه من استجابة الناس له، ونفاذ أمره فيهم. لكن علينا أن نتذكر أموراً تمحو هذه الشبهة:
أولها:أن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه، والكلام المنسوب إلى الله تعالى، فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاً، ولا نسبة ما نسبه على ربه بزائدة فيه شيئاً، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، فكانت حرمتهما في النفوس على سواء.
ثانيهما:أن هذه الشبه مبنية على افتراض باطل، وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من الذين يرون الوصول إلى غايتهم بأية وسيلة كانت، مستبيحين الكذب والتمويه، فالواقع التاريخي يؤكد أنه عليه السلام، كان في حركاته وسكناته، وفي رضائه وغضبه، وسائر جوانب حياته مثالاً في دقة الصدق وصرامة الحق، وأن ذلك كان من أخص شمائله قبل الرسالة، وبعدها.
وسنته المطهرة زاخرة بالمثل الواضحة الدالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي هذه.
ومن ذلك: أنه عليه السلام كانت تنزل به نوازل نحفره على القول، وتلح عليه أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لسارع إلى الكلام، لكنه كانت تمضي الأيام والليالي، ولا يجد في شأن ما نزل به قرآناً يقرؤه على الناس، من ذلك ما أرجف به المرجفون من حديث الإفك، فقد طال الأمر وأبطأ الوحي والناس يخوضون، ولو كان الأمر إليه، لسارع إلى تبرئتها صيانة لعرضه، لكنه صلى الله عليه وسلم ظل صابراً حتى نزل بعد طول انتظار صدر سورة النور معلناً براءتها.
ثالثاً:صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الذكاء الفطري، والبصيرة النافذة، ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء، والحسن والقبيح من الأخلاق.
إلا أن ما في القرآن الكريم لم يكن كله من هذا النوع الذي تبلغه بالملكات البشرية مهما بلغ اكتمالها.
إذا أضفنا إلى ذلك ما تضمنه القرآن من أمور غيبية تقع في مستقبل الأيام ثم تتحقق كما أخبر عنها تماماً، دون أن يتخلف منها شيء ازددنا يقيناً بأن القرآن الكريم، ما هو إلا وحي يوحى، وأنه لا سبيل للقوى البشرية إليه بحال، كما أخبر أن الروم سيغلبون الفرس بعد بضع سنين، وليس ذلك فقط بل سيواكب هذا تزامن معه أن ينتصر المسلمون على أعدائهم.
يقول سبحانه:(غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (6) [سورة الروم].
وتمضي الأيام ويتحقق وعد الله تماماً كما أخبر.
ومن ذلك أيضاً: وعد الله بحفظ كتابه الكريم بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون .
وتمضي الأيام وها هو كتاب محفوظ بعناية الله وحفظه، على الرغم مما دبر له من مكائد وما مر بالمسلمين من محن، بل إننا نرى عجباً، فكلما هجس في خواطر الغيورين على كتاب الله هاجس يمس حفظ كتاب الله رأينا من أساليب الحفظ وأساليب تلقيه نقياً كاملاً بأصوات قراءة يتلونه حق تلاوته، كما أنزل من مخارج حروفه حرفاً حرفاً لا ينقص منه مدة ولا غنة، مما لا يخطر على بال أحد، من إذاعات متخصصة وتسجيلات وحكمة، ومن تسابق الغيورين على البذل في القيام بحق لكتاب الله.
وهكذا يصل الدكتور / دراز بالقارىء، إلى الاقتناع العقلي والاطمئنان القلبي بأن القرآن الكريم إلهي المصدر.
وينتقل بعد ذلك إلى مرحلة الدراسة في جوهر القرآن نفسه، هدفها إثبات أن القرآن الكريم معجز من أي ناحية جئناه.
وتحت عنوان: ( الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم ) يدير الدكتور / دراز حواراً هادئاً يناقش ويقنع دون تعسف أو انفعال، شأن الواثق بنفسه، فيستعرض الشبهات التي يمكن أن تثار حول الموضوع ويجيب عنها بما يشفي به الصدور من ذلك ما قد يقال من أننا إذا سلمنا بأن سكوت العرب عن المعارضة كان عجزاً إلا أننا لا نرى من الناحية اللغوية للقرآن الكريم ما يمكن أن يكون سبباً في الإعجاز، لأن القرآن لم يخرج عن مفهوم العرب في لغتهم، فمن حروفهم ركبت كلماته، ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليف، فأي جديد في ذلك كله حتى نقول: أنه جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية؟.
والجواب: أننا نسلم بأن القرآن لم يخرج في لغته عن سنن العرب إفراداً وتركيباً، لكن هذا لا يمنع أن يأتي القرآن بما يعجز الجميع.
ويورد الدكتور / دراز شبهة أخرى فحواها، أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان، لم يصلوا إلى طبقة البلاغة المحمدية، وهذا القصور الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة كلامه، هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه، فلا يكون هذا العجز حجة على قدسية القرآن، كما لو يكن حجة على قدسية الأسلوب النبوي؟.
الجواب: أننا نسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، لكن: أكان هذا التفاوت بينه وبين الناس مما يتفق مثله في العادة بين بعض الناس وبعض في حدود القدرة البشرية، أم كان أمراً شاذاً خارقاً للعادة بالكلية؟ ولا بد من التسليم بأن ما كان بين الرسول وغيره من تفاوت في الأسلوب، هو ما يكون بين بليغ وبليغ، وبين الحسن والحسين.
فقد نقرأ القطعة من البيان النبوي، فنطمع في مجاراتها، وقد نقرأ الحكمة فيشتبه علينا أمرها، أمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام الصحابة والتابعين، أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعاً لا يلتبس معه بغيره، ولا يجعل طامعاً يحوم حول حماه.
بل إننا نقول: لو كان القرآن صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب أن ينطبع ذلك على سائر كلامه صلى الله عليه وسلم كما انطبع على القرآن، لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين، ولكننا نرى الأسلوب القرآني ضرباً وحدة الأسلوب النبوي ضرباً وحده.
ينتقل بعد ذلك د / دراز إلى الحديث عن خصائص الأسلوب القرآني وأولها ما يسميه القشرة السطحية للجمال القرآني.
فيقول: أول ما يسترعي انتباه المستمع للقرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي، ذلك أننا حين ننصت عن بعد إلى قارىء يرتل القرآن حق ترتيله، بحيث لا يصل إلى مسامعنا جرس الحروف وإنما نسمع فقط حركتها وسكناتها ومدَّاتها وغناتها واتصالاتها وسكناتها، سوف نجد أنفسنا بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لوجود هذا التجديد ـ بل إننا سنجد فيه شيئاً لا تجده في الموسيقى والشعر، لأن القصائد تتحد فيها الأوزان بيتاً بيتاً، وكذلك الموسيقى تتشابه أصداؤها وتتقارب فلا يلبث السمع أن يملها بينما نحن مع القرآن في لحن متنوع متجدد يأخذ بأوتار القلب.
ثانياً: الخصائص البيانية للقرآن الكريم:
يرتب الدكتور / دراز دراسته لهذا الجانب على أربع درجات:
أـ القرآن في قطعة قطعة منه، ويعني بالقطعة ما يؤدي معنى كاملاً، يؤدي عادة في بضع آيات وقد يؤدي في آية طويلة أو سورة قصيرة، وهو الحد الأدنى للتحدي.
وفي هذا الجانب لا يرى في وصف القرآن خيراً من أنه تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها، على تباعد ما بين أطرافها. فهو يجمع أولاً بين… القصد في اللفظ الوفاء بحق المعنى.. فالذي يعمد إلى إيجاز اللفظ لا مناص من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراً، فإن حرصه على الإيجاز يحمله على بذل جهده في ضم أطراف المعنى، وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشويق، ووسائل التثبيت والتقرير، إلى غير ذلك مما تمس حاجة النفس إليه في البيان، فيخرج ثوباً متقلصاً، يقصر عن غايته.
أما الذي عمد إلى الوفاء بحق المعنى، وإبراز دقائقه، فلن يجد بداً من أن يمد في نفسه مداً، لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يؤدي عن نفسه رسالتها كاملة، فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك باعد بين أطراف كلامه وأبطأ في الوصول إلى غايته.
والدليل على ذلك: أن البليغ حينما يتعقب كلام نفسه ـ الفينة بعد الفينة ـ يجد فيه زائداً يمحوه أو ناقصاً يثبته ويجد فيه ما يقدم أو يؤخر، كما يروى عن زهير ـ وهو من هو.
في تهذيب قصائده التي كان يسميها ( الحوليات ) لأنه كان يقضي عاماً كاملاً في تهذيبها قبل أن يطلع عليها أحداً.
أما القرآن الكريم، فإن هاتين الغايتين على أتمهما فيه، فحيثما نظرنا في القرآن نجد بياناً قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير، يؤدي لنا من كل معنى صورة نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها، وافية لا يشذ منها شيء من عناصرها الأصلية، ولواحقها الكمالية، كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه.
كما يجمع القرآن بين خطاب العامة وخطاب الخاصة… فإننا لو خاطبنا الأذكياء بالواضح المكشوف الذي نخاطب به الأغبياء لنزلنا بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم.
ولو أننا خاطبنا العامة باللمحة الدالة والإشارة المعبرة لجئناهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم، أما في القرآن الكريم فإن جملة واحدة منه تلقى إلى العلماء والجهلاء، وإلى الأذكياء والأغبياء، وإلى السوقة والملوك، فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله. وعلى وفق حاجته، وهذا شيء لا يوجد على أتمه إلا في القرآن الكريم.
كما يجمع القرآن الكريم بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة. فإن قوة التفكير في الإنسان تبحث عن الحق لمعرفته، عن الخبر للعمل به، أما قوة الوجدان فإنها تسجل إحساساً بما في الأشياء من لذة وألم، والبيان التام هو الذي يوفي بهاتين الحاجتين، يمنح النفس حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معاً، وهذا أمر لم يأت على أتمه إلا في القرآن الكريم.
كما يجمع القرآن أيضاً بين ( البيان والإجمال )، فإن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم، لم تتسع لتأويل، وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام والإلباس، أما بالنسبة للقرآن الكريم، فإننا نجد في أسلوبه من الملامسة الشفوف والخلو من كل غريب ما يجعل ألفاظه تسابق معانيها إلى النفس، ولكننا إذا أعدنا الكرة، ونظرنا فيه من جديد، رأينا أنفسنا بإزاء معنى جديد، يلوح لنا غير الذي سبق إلى فهمنا أول مرة، حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة، وجوهاً عدة، كلها صحيح أو محتمل للصحة، وللنظر في قوله تعالى: (والله يرزق من يشاء بغير حساب( لنرى مصداق ذلك:
فهذه الكلمة على ما بها من وضوح في المعنى، إلا أنه بها من المرونة ما يبيح لنا أن نذهب في معناها مذاهب متعددة: فإذا قلنا في معناها:
أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه، ولا سائل يسأله. لماذا يبسط لهؤلاء ويقدر على هؤلاء. أصبنا. وإذا قلنا: أنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الاتفاق خوف النفاد أصبنا ـ ولو قلنا أنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب أصبنا. ولو قلنا: أنه يرزق من يشاء بغير معاتبة ومناقشة على عمله أصبنا، كما لو قلنا: أنه يرزق من يشاء رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر ولا حساب أصبنا. ويكون في هذا أو ذاك وعد للصالحين. إما بدخول الجنة بغير حساب أو بمضاعفة الأجر أضعافاً مضاعفة كثيرة لا يحصرها العد.
وهكذا نرى أن ما تم به القرآن من مرونة في النص الكريم وسف الفرق الإسلامية كلها على اختلاف منازعها، كما وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها.
وينتقل د / دراز بعد ذلك إلى النظر في القرآن كوحدات أكبر، فتحت عنوان: ( القرآن في سورة منه ) يذكر أن ذلك يؤدي بنا إلى ملاحظة الجمع بين ( الكثرة ) و (الوحدة ) في كل سورة.
فمن المعروف: أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل منجماً حسب الوقائع والدواعي المتجددة، وكان الرسول عليه السلام كلما نزلت عليه آية، أمر كتاب الوحي بأن يضعوها في مكان كذا من سورة كذا، دون اعتبار لترتيبها حسب نزولها.
واستمر الحال على ذلك منذ بعثته عليه السلام حتى قبيل وفاته ( زهاء 23 سنة )، والرسول عليه السلام بشر، ما كان ليدري ما ستجيء به الأيام من أحداث، ولا ما سيكون في مستقبل الزمان من قضايا، وبالتالي: لم يكن يعرف ما سينزل بشأنها من قرآن.
وتمضي الأيام وآيات القرآن بتتابع نزولها والرسول يأمر بوضعها مواضعها التي يشير إليها، موزعة على السور، حتى اكتمل نزول القرآن. فإذا نحن أمام بناء متناسق متكامل تتآخى أجزاؤه. وتأتلف وتنسجم، ولا يؤخذ عليه شيء من التنافر أو التفاوت بين شيء من أجزائه، حتى أن الناظر فيه دون أن يعلم بنزوله منجماً، ولا يخطر بباله أنه رتب بهذه الطريقة.
إن ذلك ولا شك دليل قاطع على أن القرآن الكريم كلام الله لا كلام بشر.
ويرى الدكتور / دراز أن هذا النهج الكلي في دراسة النسق القرآني هو السياسة الرشيدة، التي يجب أن تتبع، فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء وجزء، إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها، بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها العامة، فالسورة مهما تعددت قضاياها، فهي كلام واحد، يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة.
ولا نجد ما نختم به دراستنا ( النبأ العظيم ) خيراً من قوله صاحبه: ( لعمري لئن كانت للقرآن الكريم في بلاغته معجزات وفي أساليب ترتيبه معجزات، وفي نبوءاته معجزات، وفي تشريعاته الخالدة معجزات، وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات. لعمري أنه في ترتيبه آية على هذا الوجه معجزة المعجزات).
وبعد: أيها القارئ الكريم: ماذا نأخذ وماذا ندع لنبيين أن القرآن الكريم معجز، أنه في الحقيقة معجز من أي ناحية أتيناه، إنه معجز في بلاغته، معجز في ترابطه وتماسكه، معجز في تشريعاته وهدايته، معجز في معارفه وعلومه، معجز في غيوبه وأسراره، إنه روح من الله، صدق فيه قوله سبحانه: ) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ )صدق الله العظيم. وصدق نبيه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
* * *
أ.د. / عبد الغني محمد بركة
تم نشر المقالة بالتعاون مع جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ـ مصر القاهرة